إنَّ شعرية “مظفر النواب” تلخص حياته، فكل قصيدة تعد محطة مكانية توقف عندها لبعض الوقت وتملاّها جيداً في كل أبعادها وأفرغ شحنته الشعرية عند عتبتها، لذلك صار الزمان في عرف “النواب” هو ((الوجود الذي لا يكون موجوداً أثناء وجوده، والذي يكون موجوداً أثناء لا وجوده)) حسب تخريج “هيغل”(1).
في مجموعته الشعرية الكاملة(2)، وجدنا أن “النواب” قد عالج أفكاراً هامة وقضايا متنوعة، والتصدي لقراءتها أو مقاربتها يستدعي منا إيجاد مبررات مشروعة للانتقال من قضية إلى أخرى ومناقشتها ضمن المسوغات المعقولة، وذلك لتبرير وجود هذا الكم المنطقي من المساءلات والمشكليات النقدية، ما دمنا نرى بأن الجدل حول سلسلة من القضايا الثقافية يدور حول دراسة أفعال لغوية صنعت القصائد أو صنعتها القصائد.
وسنعطي لأنفسنا كامل الحرية في تعليل الانتقال بين الوحدات التواصلية في لغة الشعر النوابي من منظور ثقافي صرف، إذ أن الأمر يتعلق بقضايا مرتهنة بأفعال قولية، أي أنه يتعلق بكشوفات وإيحاءات وفضائح ترتكبها القوى الحاكمة بعقل ممنهج وقلب مبرمج على آلية القتل والاضطهاد والقمع الوحشي المفرط. كما سنعفي أنفسنا من تعليل القصائد من منظور شكلي أو أسلوبي إذ أن الوحدات التداولية في جميع القصائد قد قامت سلفاً بتأويل علاقاتها المرجعية المتميزة بالواقع الخارجي المبتلى والممتحن، علاقة بعد علاقة، بينما يتوجب علينا بعد جهد استقصائي أن نكشف عن الصلة القائمة بين القضايا والواقع.
وسنرى بعد حين، إنَّ “النواب” لم يكتف بابداء عناية خاصة بظاهرة إنعدام – ضرورة الاستئناف بين القضايا المنتمية إلى أنماط استعمال متباينة (وهي أفعال القول) بل اعتبر، فضلاً عن ذلك، بأن انعدام – الضرورة هذا يمثل فصلاً نوعياً يختص بالجدل الثقافي (على خلاف نقاد الأدب التقليديين الذين اعتبروا انعدام – الضرورة بمثابة نقيضة نظرية أو مثلبة منهجية) لذلك، فهمنا مبكراً، إنَّ الدخول بقوة في لعبة الجدل الثقافي التي تكتنف الخطاب الشعري (والأدبي عموماً) في ضوء التوقعات القرائية تستحق منا كل الاهتمام في وضع تواصل نموذجي مع شعرية شامخة في السماء، متجذرة في الأرض، كقامة شاعرها “مظفر النواب”.
لمعاني النبيلة وسياقاتها:
إنَّ نموذج القصيدة النوابية يجعل تحديد المواضيع المتناولة في القصائد وظيفة قابلة للجدل المستمر لإعادة تنظيم المعاني المعطاة بوتيرة عالية وعلى أفضل مستوى من التماسك، هذا المنهج التداولي في القراءة -عادة- ما ينفي أو يبعد الاتجاه الأحادي في القراءة، لأننا، وبضغط من القصائد ذاتها، نعود باستمرار إلى معالجة المواضيع المطروحة في القصائد وآلية إعادة تنظيمها وربطها مع السياق الذي جاءت منه. فعالم القصيدة النوابية لا يحتاج إلى تنقيح جزئي أو كلي، ثابت أو مستمر، لأنه عالم يعج بالمعاني النقية المنقحة أصلاً بفعل مسارب (فلاتر أو مصافي أو مرشحات) الخبرة الشخصية والخبرة العامة، وهي خبرات نضالية بامتياز.
من هنا، تغدو القراءة امتداداً للتجربة المطروحة في النص، لذا فإن التعالق بينهما يؤدي إلى دفع الوعي القرائي إلى أن يكون في مستوى التجربة المقروءة، وهي تجربة حدثت في الماضي النضالي القريب تحديداً، وبذلك تحوز على الاستحسان والتثمين، ولحظة التثمين هي لحظة راهنة، إبنة الحاضر، وهنا يظهر التعالق بين الماضي (التجربة) وما يحدث الآن (أن التثمين) وهو تعالق يفرز تفاعلاً قرائياً جاداً بين ما حدث في الماضي وما يحدث في الحاضر، كل ذلك يجري أثناء القراءة ومن جرائها، فاكتساب الخبرة من التجربة المزروعة في النص ليس مجرد إضافة قرائية، بل إعادة شحذ ما وعيناه في تجاربنا الحياتية، وما خبرناه من اندماجنا مع المعترك السياسي- الاجتماعي.
إنَّ القصيدة النوابية - وهذه إحدى خرافاتها واختراقاتها- عندما نقرأها تعيد تركيب ما نملكه بجدارة قل نظيرها. ولنقرأ الآتي:
((أي إلهي.. إنَّ لي أمنية ثالثة/ أن يرجع اللحن عراقياً/ وإن كان حزين/ ولقد شط المذاق/ لم يعد يذكرني منذ اختلفنا أحد في الحفل/ غير الاحتراق/ كان حفلاً أممياً/ إنما قد دُعي النفط ولم يدع العراق)). (ص3 وما بعدها). ((إذا كنت بلا أمل/ يا صاحب هذا الفلك المتعب أنت تسميه المركب/ لا بأس عليك تفاءل ما شئت/ إطلق ما ترتاح من الأسماء عليه/ وصيف وبغي متفقان على نفط البصرة/ والمتوكل مشغول عن ذاك بشامة حسن في خصيته/ فدع الريح تهدهد هذا المركب شيئاً/ واسترخ فما تلك نهاية هذا العالم/ مد ذراعك/ فالشمس تريح الجسد المكدود/ تمد مرونتها فيه فيصبح كالسعفة/ والفقراء المخلوقون من الخرق الليلي وخوف المتوكل/ بالسعف إحتشدوا/ ملأوا باب البصرة بالسل/ وقد اطفأ برد الليل قناديل حماستهم/ كان السياب مع الأطفال يحرك سعفته/ إنتظروك طويلاً)). (ص111 وما بعدها).
محو الذات والصدق الفني:
إنَّ قراءة شعر “مظفر النواب” تقودنا إلى محو الذات، وهذه من مميزات الشعرية التي تعالج قضايا مصيرية لا تدخل في باب “التأمل الرومانسي” أو “الإستغراق الذاتي” لكنها توصلنا إلى معنى يشير إلى مداليل جمة خارج ذاته، لذلك فهي مشحونة بكمية كبيرة من الصدق القابل للتثمين.
وما يظهر لأول وهلة في القصائد النوابية على أن له صلة غامضة بالقيم الجمالية المحصنة التي تتوفر عليها كل مقطوعة، يقلل الشاعر من شأنه في تواتر قصائده الطويلة والقصيرة، وتغدو مجرد القراءة أو السماع غاية في حد ذاتها، لكنها ليست الغاية المرتجاة من حصول “لذة” أو “متعة” نصية- قرائية، فالغاية تؤدي إلى المعرفة وتتماهى مع القضايا المصيرية العامة وتنتهي بالصدق، لا بالجمال والتلاعب بالمخيال من خلال إجتراح أشكال هي عبارة عن أساليب ماكرة/ وهذا يعني بالنسبة لمظفر النواب إدماج الشعر في الوعي العام لخلق نظام لغة تدرك ما يحصل في الواقع وما سيحصل مستقبلاً.
إنَّ هذه الإزاحة ما بين الواقع والتخييل تنطوي على أكثر من شعرية أو أدبية، إنها تضعنا أمام مسؤوليات كانت قد رفضت واستهجنت من النقد الأدبي التقليدي، فهي تشير إلى ظهور فهم جديد يواكب الواقع المستجد الذي ظهر بكل عنفه وخداعه، ويمكننا من خلال القصائد المتحصلة على لغة شرسة، طازجة، أن تقتنع بكل ما يجري ويحصل أمامنا، وفي ضوء ذلك تغيير المنظور وزاوية الرؤية التي تنظر من خلالها إلى ما يجري ويحصل. فيستطيع المتلقي استناداً إلى تلك القصدية الوجودية والعقلانية والظاهراتية أن يتصور الوجود بما هو موجود كواقع حال وليس كلحظة عابرة، واقع حاضر وموجود وضاغط على عقولنا وأجسادنا وموارد رزقنا ومستقبل أجيالنا. وإن طعم المرارة الملتصق بأفواهنا ناتج عن مرارة الحياة اليومية التي نعيشها كقدر مكتوب منذ الأزل (هذا ما تعاقد عليه سدنة الحاضر مع مرويات الماضي المكبل بالزيف والإفتراء).
إنَّ القيمة العظمى لشعرية “مظفر النواب” أو الشعريات الثوروية الأخرى لا تظهر إلا بالتناسق الخالص بين النص والقارئ، وعلى الإستجابة الفورية، العفوية، لمزاجية النص. ومن المتوقع أن كل إستجابة قرائية تجلب معها قرائنها النظرية الخاصة بها، كما وتجلب معها مشاكلها الخاصة، وهي مشاكل متعلقة بالذائقة الفردية وبثقافة الفرد الخاصة، وبأفق التوقع المستند الى تاريخ سري من الانهمام بالشؤون العامة. ثم هناك المرجعيات القومية والدينية والعرقية الذاهبة دوماً إلى توجيه إبرة بوصلة القراءة والتحليل والتذوق. لكن القصيدة النوابية تقفز فوق كل ذلك لتحقق وحدة نادرة أو ندرة واحدة لا تؤمن إلا بالإنسان بوصفه عائشاً وسط حرب طبقات وأعراق ودول مستعرة منذ غابر الأزمان ولا تتوقف حتى نهاية التأريخ، بعيداً عن تجزيئات هذا الإنسان، فهو بالمطلق الممتحن الأول والأخير، والخاسر الأول والأخير، والمهزوم على طول الخط، والصارخ في برية متمدينة. فهو ضحية قانون الغاب، والفريسة المثالية لكل المفترسين. ولنتمعن بالآتي:
((أدين بموتك/ أن رؤوس الأموال وراء الأشياء/ أدين بموتك/ لكن الصمت يعض على قلبي)). (ص7). ((والأيتام سيجتمعون إليك بأمعاء فارغة/ وعيون فارغة/ وأماني فارغة/ وملابس من صدقات السلم/ وأنت تزور بيوت الفقراء/ سيرونك تحمل صرة حزن مثل جميع الفقراء)). (ص8 وما بعدها).
((والعثة في بلد العسكر/ تفقس بين الإنسان وثوب النوم وزوجته/ وتقرر صنف المولود/ وأين سيكون ختم السلطان/ فإذا آمن بالحزب الحاكم فالجنة مأواه/ وويل للمارق/ فالأنظمة العربية تشنقه قدام الدنيا قاطبة/ تبقيه لساعات/ ثمة تنسيق سري بين فنادقنا/ أحد منكم لاحظ أن الصمت تكاثر والجرذان/ وسيارات الشرطة تحبل في الطرقات/ بشكل لا شرعي وسخ/ هذا الطقس دنيء جداً/ ولذلك خبأ في الصدف الحي حكايته)). (ص105 وما بعدها).
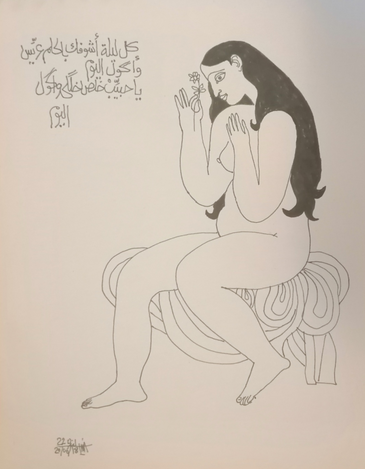
الراسب الجوهري والذاكرة المختزنة الحيّة:
تحوّلت قراءة القصيدة النوابية إلى إعادة صياغة لتجربتنا الحياتية مع الحقائق الثقافية. وهي عملية جدلية وجدالية لإنضاج النص الذي يعاد فيه تنظيم العناصر المكونة للجزيئات الواقعية المأخوذة من الواقع، وإدماج هذه الجزئيات في مستويات قرائية عالية التماسك، وبذلك يحدث استرجاع تام للتفاعل بين الشعر والقارئ، أكثر مما يهدف إلى تحقيق قيمة جمالية أو شكلية أو أسلوبية من التي تهتم بها النقدية التقليدية، ويحتفي بها علماء الإستيطيقا الذين تثير انتباههم مثل هكذا ألعاب لغوية.
إنَّ قراءة النص النوابي قد تكشف عن اتجاهات كامنة، لكن هذه الاتجاهات وكنويتها لم يحددها الواقع الخارجي المعيشي، بل النص نفسه، لأن منتج هذا النص له وجهة نظر خاصة ومعروفة، وهذا ما يحكم الإستجابة الواسعة للنص النوابي، فعملية فهم النص ليست عملية خاصة بكل قارئ، وهي لا تؤدي إلى أحلام اليقظة، أو إلى المتعة القرائية، ولا تؤدي إلى تحقيق آمال قصيرة الأمد أو بعيدة الأمد، بل تؤدي إلى تنفيذ ما تعاهد عليه الشاعر والنص من شروط وضعت في صلب النص، وهذه الشروط هي “الراسب الجوهري” الذي يميز القصيدة النوابية عن غيرها من القصائد الثورية، الراديكالية، المتمردة، والمهيجة لعواطف الجموع. إنه راسب مقنن في وجهة نظر معينة، ومكيّف ضمن منهجية واضحة، ويمثل حقيقة جهوية لا تخفى على الجمهور، لأنها تشكل الذاكرة المختزنة التي تقتات عليها القصيدة والجمهور معاً. والذاكرة المدخّرة جمعت من السياقات التي يمكن للنص أن يمتص مواده منها، ويجمعها ويخزنها في قيعانه لكي يطلقها حال لحظة القراءة.
إنَّ إعادة تفعيل الذاكرة المختزنة الحيّة التي يكتنزها النص هي في الحقيقة إعادة فهم واستيعاب للمعايير الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تسيطر وتتحكم بالواقع المعطى، وتساعد المتلقي في رؤية ما لا يستطيع رؤيته في حركة الحياة اليومية، أو ما ضاع منه في تلافيف الحياة الضاجة بالتفرعات والتفاصيل، يقول الألماني “ولفغانغ آيزر”: ((إنَّ الذخيرة تعيد إنتاج المألوف))(3)، ولكن بصيغة مستهجنة كما نعتقد. والذخيرة مخزون يدمج بالنص واقعاً محدداً بدقة، ومشار إليه بدقة، مما يحفز مدى محدداً من الخبرة الشخصية لدى القارئ وقد استحصلها من احتكاكه المرّ مع الباطل والشر والقبح. إنَّ الذخيرة في بعض الأحيان تشير إلى الثقافة برمتها والتي جاء منها النص، ولنتابع بعض من هذه النصوص:
((لا تخف.. إننا أمة/- لو جهنم صبت على رأسها- واقفة/ ما حنى الدهر قامتها أبداً)). (ص23). ((إجمعي أمة الحزن وإستأمنيها المفاتيح/ دهراً فدهراً/ فمهما بدت للوراء تسير بها النكبات/ هي الأمة القادمة)). (ص26). ((يا قاحلاً ليس فيك سوى الحزن/ يمسك رشاشة في الهجير/ إسترح لحظة يا حبيبي هنا قهوة الصبح/ أو تشتهي بالذخيرة تدخل في سورية الذارايات/ تعانق قنطرة/ ستمر مدرعة باتجاه الشمال عليها)). (ص47).
الأثر الجمالي عندما يتطور إلى وعي رافض:
في القصيدة النوابية لا يمكن للمعنى أن يبقى إلى أمد غير محدود بوصفه أثراً جمالياً، فالأثر الذي يتخلف في ذهن القارئ ويتطور إلى وعي سلبي، نافي، رافض، يدل على أن القصيدة النوابية تنتج شيئاً لا يمكن أن يعد جمالياً فقط، ما دام بقدرته توسيع معناه ليشمل شيئاً آخر يقع خارج القصيدة، وخارج المألوف، وخارج المزاج القرائي. إنه يشير إلى الظلام الدامس الذي حل في الماحول، وانتشر في كل المسارب والفجوات. الظلام الذي ليس بمقدور أقوى الأنوار والأضواء تخفيفه أو تلطيفه أو تحجيمه.
في القصيدة النوابية تجري إثارة التوقعات التي ظلت حبيسة في اللاوعي الجمعي والتي يعتمد عليها “المكبوت” في عودته، فعودة المكبوت تحتاج إلى إثارة وتحفيز. وهكذا يصبح إنتاج الشعر عند “مظفر النواب” كشفاً مطولاً ومجدولاً للنقد الذاتي، ومحاسبة الذات، ومراجعة الخيارات، وتصحيح المسار:
((أفل الليل/ وقبرك في الأفق الشرقي يوازي السعف/ يوازي همسات السعف/ وثمة طير منكفئ تدفعه الريح/ ورأسك في الطين البارد ساكنة/ ترتاح إلى حجر/ أرحم من هذي الدنيا وسفالتها/ فالعالم آلة إيذاء)). (ص5). ((قضيتنا لنا وطن كما للناس في أوطانهم نزل/ وأحباب وأنهار وجيران/ وكنا فيه أطفالاً وفتياناً وبعضاً صار يكتهل/ وهذا كل هذا الآن مغتصب ومحتل ومعتقل/ قضيتنا سنرجع أو سنفنى مثلما تفنى/ ونقصف فوق ما قصفوا/ ونقتل ضعف ما قتلوا/ فإرهاب بعنف فوق ما الإرهاب ثوري/ يميناً هكذا العمل/ أقول ويمنع الخجل/ بشجّ العين يكتحل/ وكيف عروسكم حصص وحصتكم بها نغل)). (ص85). ((أي ذل يذلون قلبي يدسون في جرحه كلمات التبرع/ ومن يطفئ النار بالنار لا بد شاهد شيئاً/ وراء الأمور وأوشك مما يبين بهم لا يبين)). (ص159).
التجربة المتعينة في العيان الملموس:
إذا فهم الشعر على أنه فعالية لإنتاج الصور الشعرية، فذلك يعني أن المعنى النبيل الذي تنطوي عليه كل الشعرية يصبح حدثاً زائلاً، والمسلمات التي يطرحها الشعر تضحى مسلمات غير مقنعة، لأنها إبنة لحظتها الزمنية التي سرعان ما تختفي حالما يتقدم الزمن إلى نقطة أعلى.
ولأن الشعر في قناعات “مظفر النواب” هو التعبير الأمثل لقضية حساسة. فالصورة الشعرية لديه في مجملها لا يمكن أن تتخلص من عث التقادم إلا إذا تحصلت على الصدق، والصدق لا يأتي إلا إذا توفرت الصورة الشعرية على هويتين مختلفتين ووظيفتين متنوعتين، فالشعر ينبغي أن يكون له وجودان، أحدهما فرضية واقعية (واقع افتراضي)، والآخر ميدان مرجعي (سياق اجتماعي أو تأريخي أو سياسي أو ثقافي... الخ)، وعندما يريد أن يخلق عالماً جديداً، فريداً وساحراً، مع كل قصيدة، عليه أن يمحو ذاته كي يشير إلى قضية حساسة حاضرة دائماً في عنف الواقع. إنَّ هذه الهوية المزدوجة لا تخضع لمزاج الشاعر أو لمزاج عام، فكل محاولة لتحديد القصيدة وهي في مرحلة جنينية تعوض الغياب المستمر بوجود دائم، فيفقد القارئ عالمه المألوف لكي يركز على لغة العالم غير المألوف. والعالم غير المألوف سيجده في تشخيص الإشارات المألوفة وقد أغدقها الشاعر بوقرة في نصه، لكي تجعل موضوعاتها يتخلص من أقنعة الإبهام بسبب عملية خلق وعي متوتر في قصدية القراءة، وهذه إحدى الجداليات القرائية التي تجري بين الذات والموضوع، ذات الشاعر وموضوعه، أو ذات القارئ والنص المقروء، وطرفا هذه الجدالية يرتبطان بعلاقة تبادلية بتوسطية الفعل الذي يحدث بينهما، ويرتبط ذلك الفعل بموضوع له مقصديات ستتوضح شيئاً فشيئاً في أثناء تقدم القراءة. وبعبارة أخرى، فالقصيدة النوابية لا تختار المدلول أولاً أو المشار إليه ثم تبحث عن وسيلة للتدليل أو للتأشير، بل تحوّل قصد الشعر إلى سياقه الذي جاء منه، فيصبح البحث عن الحقيقة الصادمة هو المشار إليه أو المدلول الذي يجب القبض عليه وتقديمه للقارئ بكل شفافية وصفاء، فينصهر بهذه الطريقة التخييل والواقع، التأمل والإدراك العميق في إيماءة واحدة، ولا شطب هذا الفهم التجربة الجمالية لأنه قد أصبح هو نفسه العيان الملموس الذي يؤدي إلى تلك التجربة المتعينة، وهي تجربة ثقافية بدون شك:
((أغرب الأمر... بعض الشحارير/ لما رأتني لست أحط على الفضلات كأحوالها/ نبحت كالكلاب/ إلهي إني كفيل بتلك تكفّل بهذي/ فأنت خلقت جناحاً لها لتغني/ فصارت تهرّ/ تعض وأخشى تعضك أنت كما الآخرين)). (ص42 وما بعدها). ((ليس بين الرصاص مسافة/ أنت مصر التي تتحدى/ وهذا هو الوعي حد الخرافة/ تفيض وأنت من النيل تخبره/ إن تأخر موسمه/ والجفاف أتم إصطفافه/ وأعلن فيك حساب الجماهير/ ماذا سيسقط من طبقات/ تسمي إحتلال البلاد ضيافة/ ولست قتيل نظام يكشف عن عورتيه فقط/ بل قتيل الجميع)). (ص93).
علاقة الأنا بالآخر (ولادة الهوية):
إنَّ مفهوم الهوية في شعرية “مظفر النواب” تنطلق من علاقة الأنا بالآخر، فالهوية الشعرية ومن ثمَّ الهوية الشخصية تأتي من التجربة الحياتية، من الاحتكاك القوي بالواقع المعيشي، ولا يمكن الفصل بين الهوية والتجربة الذاتية، فالهوية مهما كانت مفقودة فهي تعيد نفسها من خلال التعامل مع “الآخر” الذي يحتكر الواقع لمصلحته.
إذن، الذات هي التي تخلق هويتها، والهوية تغدو علامة مائزة للذات، تميزها عن الآخر، العدو، الآخر، المتسلط، المتجبر، المختل، الذي لا يمتلك إلا بطشه وجبروته، ومع ذلك، لا يمكن إلغاء طرف من هذه المعادلة، أو أن نقول إن طرفاً من المعادلة هو أصل للطرف الآخر، أو أن أحدهما لا يوجد من دون الآخر (وهذا وارد في علم السياسة والحصانة والتأويل)، فكلاهما لا يوجد إلا من خلال التعامل اليومي مع تعقيدات الواقع وغموضه، والجدلية المستمرة لهذا التعامل هي التي تخلق الهوية بكامل تماسكها.
إنَّ الهوية تعيد خلق ذاتها عن طريق إمتصاص كل الاحتكاكات والخروقات إلى ذاتها، من هنا جاء نجاح القصيدة النوابية لإعادة خلق كيان شعري قابل للقراءة المستمرة، عصي على التقادم، يخاطب مختلف القراء، ومختلف الأمزجة، وأجيال عدة.
فالهوية تكون فاعلة عندما تناسب كثرة كاثرة من القراء، وخيالات القصيدة تعكس خيالات الجمهور، وأنا الشاعر تتحوّل إلى أنوات المتابعين لها، فالهوية هي إبنة التطابق والتشابه والتقارن والمقايسة مع جمهور القراء، ولكنها عامل إختلاف وإحتراب مع الآخر – المستثمر لمغانم الحاضر وقد سيطر عليه حتى الإختناق.
إنَّ التطابق والتشابه وما إلى ذلك هو وليد الشرعية الثورية، وصياغة الهوية الشعرية أو الهوية الخاصة ومن ثمَّ إقرار شرعيتها يعتمد على المنطق التقدمي الذي يوجه أصابع الإتهام والمعارضة إلى الآخر، ثم أن هناك صلات سببية مهمة تعتري علاقة الهوية مع نفسها أو مع الآخر، وصلات صورية (وليدة المنطق الصوري والرياضي) توافق هذا النمط من الشعرنة والصيغ اللفظية التي تفضلها أنا الشاعر في مخاطبة الجمهور من جهة، والآخر من جهة أخرى، وهي مخاطبة مباشرة وصريحة، وليست مبطنة أو إيحائية، فالصراحة الموضوعية والتأريخ النضالي الشخصي (الأسطورة الشخصية) ونتائج الإختبارات التجريبية تندرج ضمن هذا الاطار. كل ذلك يوصلنا إلى نتيجة مؤادها أن ((ثيمة الهوية التي تشتق من معطيات غير أدبية تنسجم مع الثيمة المشتقة من الإستجابات الأدبية))(4)، حسب اعتقاد الأمريكي “نورمان هولاند”:
((باليدين الفدائيتين غدوت إله/ وإلا فإنك مما يكدس أهل الكلام/ ثمل ليس عيب على ثمل بالسلاح/ فإن العراق قديم بهذا الغرام/ أيها السكر كم قد سكرت بنا بالعراق/ وأسكرتنا/ ثم بمرارة غربة العمر/ فبعد العراق جهلنا ننام/ وإفترشنا لهيب الرمال/ فواحاتها غازلتنا بجرعة ماء/ رأينا الخناجر فيها/ وما للغريب سوى واحة أن يكون الصيام/ أرفع الكف جبيرة جرحت نفسها/ كذبوا ما انتميت لغير لهيب الدهور/ كذب المنتمون لكل نظام/ إنني شارة في طريق الجماهير ضد النظام)). (ص45 وما بعدها).
الإستجابة الثقافية والإمكان المعرفي المعمم:
مما لا شك فيه أن المعنى الذي يريده الشاعر في قصيدته يحتاج إلى استجابة ثقافية (وهي أشمل من الإستجابة الأدبية وأكثر قدرة على توليد المعاني والدلالات). وهذه الإستجابة تضمن إمكانية التشارك في المعنى بين الشاعر والمتلقي معاً، فالمعنى اللغوي الذي ينتجه الشاعر يتقيد بالإمكانيات اللغوية، لكنه يتحدد عن طريق تحقيق الإستجابة الثقافية لدى المتلقي وفعل الإرادة القرائية الذي يمتلكه، وهكذا فإن فكرة المعنى المشترك على أنه تفاوض فعال بين الشاعر والمتلقي تعد جوهر الإستجابة الثقافية، وتجسيد لنمط الثقافة أو ثقافة النمط.
تقوم فكرة “ثقافة النمط” أو “نمط الثقافة” قبل كل شيء بوظيفة القنطرة الحوارية التي تصل بين المعنى الماضي والمعنى الحاضر، بين معنى المؤلف ومعنى المتلقي، وللتوضيح التبسيطي يمكن عدّها مجموعة عليا من الإمكان المعرفي يكتسب عن طريق التعلم والتدريب ويشترك فيها أعضاء ثقافة معينة، ولها ((حدود تبين ما يعود إليها وما يقع خارجها))(5)، مثلما يؤكد الناقد الثقافي الأمريكي “إي. دي. هيرش”.
إنَّ نمط الثقافة هو الذي يستطيع الجمع بين خصوصية المعنى وسمة التأويل الاجتماعية، لذلك نرى أن النمط الثقافي الذي يؤمن به “مظفر النواب” ويشتغل في ضوئه وتحت سقفه اللساني والايديولوجي يمكن تجسيده في أي عدد من القصائد، وبهذا يمكن إستعادة المعنى الظاهري الذي أراده الشاعر في أي لحظة قرائية من قصيدة إلى أخرى، بسهولة ويسر.
إنَّ علاقة المعنى بتضميناته أو علاقة نمط الثقافة بأنساقه علاقة متبادلة بين الباث والملتقط، بحيث يمكن إعادة توليد الكل من الأجزاء، فثقافة النمط يمكن أن تتمظهر في أكثر من مثال، لذا فإنها تمتلك إمكانية سحرية في إحتواء وتوليد الأجزاء الفرعية بفضل الإستجابة الثقافية التي تحصل عليها من القراء، ومن مميزات المعنى الكبير أنه يحتفظ بتكامله وكليّته حتى وإن لم ينطق بجميع تضميناته، وبعبارة أخرى فإن المعنى الكبير ليس مجرد مجموعة من الأجزاء، بل أنه أيضاً رحماً خصباً لتوليد الأجزاء.
ولأن الاستجابة الثقافية الفورية التي تخطى بها شعرية “مظفر النواب” عند جمهور القراء العريض لافتة للنظر، ينبغي مراجعتها وفهم توظيفاتها. وحسب “دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي” فإن ((الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على العمل وعلى صنع الثقافة ومواجهة البيئة الفيزيقية الخالصة، حيث أن التكيّف البيولوجي مع البيئة هو ما يسمى في علوم الأنثروبولوجيا باسم “الثقافة”. فالتطور العضوي الذي يصاحب نمو الأعضاء إنما يتصل بالضرورة بالتطور الثقافي للمجتمعات الإنسانية، بمعنى أن التطور العضوي إنما يتجه ويتماشى في نفس الوقت مع التطور الثقافي، الأمر الذي معه نستطيع أن نؤكد أن للثقافة قيمة بيولوجية وتتعلق هذه القيمة بضرورة فيزيقية هي بقاء الكائن البشري ودوام الجماعة الإنسانية))(6)، ومعنى ذلك أن أية سمة ثقافية جزئية لا يمكن أن تفسر إلا بردها إلى سياقها الثقافي الكلي الذي يمنحها مبناها ومعناها كما أن كل حاجة إنسانية تقابلها إستجابة ثقافية معينة.
ومع تلك الإستجابات الثقافية الفورية من لدن الجمهور صار شعر “مظفر النواب” زاداً فكرياً ووجدانياً ضرورياً لكل فئات المجتمع العراقي وشرائحه على الأخص المجتمع العربي عموماً، ومن ضمن هذا المجتمع العريض النخب السلطوية الحاكمة، فهي تتلقف قصائده الشعرية بشقيها الفصيح والشعبي (باللهجة العراقية الدارجة) بشغف كبير وتوجس ريبي لا يقل توجساً من الموت الزؤام وخطر الانخطاف نحو الجحيم.
التضمينات الأيديولوجية:
لقد انطوت شعرية “مظفر النواب” دائماً على تضمينات أيديولوجية لا يمكن إغفالها، فهو يقف دائماً على أرض الواقع المعلّم بالتاريخ والتأرخة، ولا يفسر الممارسات الحياتية إنطلاقاً من الفكر، بل يفسر تكوّن الأفكار انطلاقاً من الممارسات المادية. بيد أن أفكار الطبقة السائدة هي في كل عصر الأفكار السائدة أيضاً، يعني هذا أن الطبقة التي تمتلك القوة المادية السائدة في المجتمع هي في الوقت ذاته الفكرية السائدة. إنَّ الطبقة التي تتصرف في وسائل الإنتاج المادي تمتلك في الوقت ذاته الإشراف على وسائل الإنتاج الفكري، بحيث تكون أفكار أولئك الذين يفتقرون إلى وسائل الانتاج الذهني خاضعة - من جراء ذلك- لهذه الطبقة السائدة. وليست الأفكار السائدة شيئاً آخر سوى التعبير الأمثل عن العلاقات المادية السائدة، بل أن هذه الأفكار السائدة هي هذه العلاقات المادية السائدة مدركة في شكل أفكار.
لقد رصد “مظفر النواب” السلطويين عندما ينزعون جلودهم لكي يتماهوا مع أية مرحلة يمرون بها، فذلك الديكتاتور الشمولي يتحوّل في مرحلة لاحقة إلى ليبرالي مقدس، تماماً مثلما يحوّل الدولة إلى المقدس، وتحوّل علاقة البرجوازي بالدولة الحديثة إلى علاقة مقدسة، إلى عبادة، وبذلك يختتم فعلاً نقده لليبرالية السياسية. لقد حوّلها إلى “المقدس”، وهذه كذلك من تحولات رجل الدين عندما يغدو بين ليلة وضحاها ليبرالياً يؤمن بتداول السلطة “سلمياً” عن طريق صناديق الإقتراع للوصول إلى السلطة من خلال تزوير بطاقات الناخبين. إننا نحاول أن نخفف من استطراداتنا في هذا الشأن، لكننا في حضرة “النواب” لا نستطيع كبح جماح الإستطراد وزخم المتبنيات الفكرية لأنها من صلب الحقل الذي حرث وبذر وزرع فيه “النواب” كل نتاجاته الإبداعية.
وحتى التوهمات في العقل البشري هي تصعيدات ناتجة بالضرورة عن مجرى حياتهم المادية التي يمكن التحقق منها تجريبياً، والتي تعتمد على قواعد مادية، ومن جراء ذلك فإن الأخلاق، والدين، والميتافيزيقا، وكل البقية الباقية من الايديولوجيا، وكذلك أشكال الوعي التي تقابلها، تفقد في الحال كل مظهر من مظاهر الاستقلال الذاتي، فهي لا تملك تأريخاً، وليس لها أي تطور، إنَّ الأمر على النقيض من ذلك، فالبشر إذ يطورون انتاجهم المادي وعلاقاتهم المادية هم الذين يحوّلون فكرهم ومنتجات فكرهم على السواء، مع هذا الواقع الخاص بهم، فليس الوعي هو الذي يعني الحياة، بل الحياة هي التي تعني الوعي(7):
((لم يناصرك هذا اليسار الغبي/ كان اليمين أشد ذكاءً فأشعل أجهزة الروث/ بينا اليسار يقلّب في حيرة معجمه/ كيف يحتاج دم بهذا الوضوح/ إلى معجم طبقي لكي يفهمه/ أي تفوه بيسار كهذا/ أينكر حتى دمه)). (ص28 وما بعدها). ((وإن العنف باب الأبجدية/ في زمان عهره دول)). (ص92). ((لكننا نقتحم التأريخ ونملأ عالمكم بالفقراء المشبوهين/ سنقرع راحتكم بيتاً بيتاً/ نخنقكم في اليقظة والكابوس/ معاذ الله أثير الرحمة في أحد/ إنَّ إثارة أي حذاء أسهل من ذلك)). (ص184). ((تعالوا فقراء الأقوام جميعاً/ نفتك نمسح أصباغ الطبقات المومس)). (ص185).
الشاعر عندما يتحوّل قديساً وشهيداً:
فالمعنى في نظام “النواب” الشعري له وجود كثيف يتمركز في كليّة خلقتها بديهيات النضال السياسي والاجتماعي وجزء من سياق أكبر. فمفهوم “نمط الثقافة” أو “ثقافة النمط” لا يُختلف وظيفياً في النهاية عن فكرة “الهوية” ومنطلقها المبدئي. إنَّ “النواب” يضع نمط الثقافة على مستوى الشخصية الفردية (الهوية المشخصنة)، ثم يطورها عندما يرجعها إلى أعراف الكتابة الثورية وليس الشعاراتية كما يقررها ويمارسها الإعلام الرسمي الموجه. وتتكرر في كلتا الحالتين علاقة الجزء بالكل وتقرر الفرق بين المعنى على أنه حدث ذاتي مرحلي (التضمينات التي يستقيها القارئ من القصيدة) والمعنى على أنه البنية- الأم، البنية الجوهرية (مبدأ الهوية أو فكرة ثقافة النمط المشتركة)، ونلاحظ في كلتا الحالتين وفي أغلب قصائد النواب أن الصياغة الجدلية لهذا التوتر تجعل مساحة النقد الثقافي التي يقترب منها القارئ أو يحاول الشروع بدخولها تتوسع وتتمدد لتشمل كل حلقات التأويل الخاصة بالنصوص الثورية أو النصوص الباطنية (السرانية وليدة العمل السري). فكل معنى مستخلص من نصوص النواب هو نتيجة وتوقع لسياق محدد بدقة ومعروف أو هو بنية مكتملة الأركان والعلائق الداخلية والخارجية. إنَّ السياقات والبنى بوصفها مراجع برهانية هي الشرط والمحصلة للمعاني الخاصة بها وقد ولت من أرحامها بسلاسة وتلقائية.
الهوامش:
- هذه المقولة وردت في كتاب: حدود التواصل-الإجماع والتنازع بين هابرماس وليوتار/ مانفريد فرانك/ ت: عز العرب لحكيم بناني/منشورات أفريقيا الشرق-الدار البيضاء (المغرب)/ ط1، 2003، ص100.
- المجموعة الشعرية الكاملة/ مظفر النواب/ دار قنبر-لندن/ طبعة 1996، وكل الإحالات الواردة في هذا البحث أخذت من هذه الطبعة وحسب أرقام الصفحات المثبتة في المتن.
- وردت هذه المقولة في كتاب: المعنى الأدبي- من الظاهراتية إلى التفكيكية/ وليم راي/ ت: د. يوئيل يوسف عزيز/ دار المأمون للترجمة والنشر- بغداد، ط1، 1987، ص63.
- دينامية الإستجابة الأدبية/ نورمان هولاند، ت: سحر توفيق الشيخ/ دار الفارابي، بيروت- ط1، 2010، ص106.
- التأويل الصحيح في التأويل/ إي. دي. هيرش/ ت: غياث العوضي/ مركز دراسات أبو ظبي الثقافية- الإمارات العربية المتحدة، ط1، 2014، ص66.
- دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي- إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة، د. سمير الخليل، دارُ الكُتبَ العِلميْة، بيروت- لبنان، ط1، 2016، ص24.
- الإيديولوجية – وثائق من الأصول الفلسفية، ميشيل فادية، ت: د. أمينة رشيد+ سيد البحراوي، دار الفارابي+ دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- ط1، 2006، الصفحات: 31، 32، 39، 46.