
كتاب "مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن" من الكتب المهمة للدكتور نصر حامد أبو زيد، صدر عن المركز الثقافي العربي، بيروت/ الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 1996. يقع الكتاب في 319 صفحة من القطْع الكبير. وتضمن مقدمة وتمهيدا وثلاثة أبواب. البابان الأول والثاني تضمن كل منهما خمسة فصول، وخصص المؤلف الباب الثالث إلى أبو حامد الغزالي (1058-1111م) ومفهومه عن النص.
الخطاب الديني والمنهج العلمي
في التمهيد يؤكد الباحث أن للقرآن في حضارتنا دورا ثقافيا لا يمكن تجاهله في تشكيل ملامح هذه الحضارة. وإذا كانت الحضارة تتركز حول "نص" بعينه، فلا شك أن التأويل وهو الوجه الآخر للنص يمثل آلية هامة من آليات الثقافة والحضارة في إنتاج المعرفة. إن البحث عن مفهوم "النص" ليس في حقيقته إلا بحثا عن ماهية القرآن وطبيعته بوصفه نصا لغويا، مستشهدا بقول الراحل أمين الخولي بضرورة الدراسة الأدبية للقرآن. إن الدراسة الأدبية ومحورها مفهوم "النص" هي الكفيلة بتحقيق "وعي علمي" نتجاوز به موقف "التوجيه الإيديولوجي" السائد في فكرنا وثقافتنا، وإن البحث عن هذا المفهوم وصياغته لا يمكن أن يتم بمعزل عن إعادة قراءة "علوم القرآن".
ويرى الباحث أن التحدي الحضاري والاجتماعي والثقافي الذي تواجهه أمتنا اليوم يختلف عن التحدي الذي واجهته منذ أكثر من سبعة قرون؛ فكان التحدي آنذاك هو الحفاظ على الذاكرة الحضارية للأمة، فكانت المصنفات في علوم القرآن محاولة لجمع التراث المتنوع في مجال "النص" الديني وتيسير تناوله على القارئ. وهذه العملية كانت تتم - بحسب رأي المؤلف- من منطلق تصور ديني للنص صاغته اتجاهات الفكر الرجعي في تيار الثقافة العربية الإسلامية، وهو تصور يعزل النص عن سياق ظروفه الموضوعية التاريخية بحيث يتباعد به عن طبيعته الأصلية بوصفه "نصا" لغويا ويحوله إلى شيء له قداسته بوصفه شيئا. ويتساءل الباحث ماذا نفعل لمواجهة التحدي، ويجيب على التساؤل بضرورة الشجاعة والجرأة في طرح الأسئلة لإنتاج "وعي علمي" بالتراث من حيث الأصول التي كوّنته والعوامل التي ساهمت في حركته وتطوره.
يؤكد الباحث أن غرض الدراسة تحقيق هدفين: الأول، إعادة ربط الدراسات القرآنية بمجال الدراسات الأدبية والنقدية، وهذه الدراسات تنتظم علوما كثيرة، محورها واحد هو "النص"؛ دراسته من حيث كونه نصا لغويا، أي من حيث بنائه وتركيبه ودلالته وعلاقته بالنصوص الأخرى في ثقافة معينة. قد يقال إن النص القرآني خاص، وخصوصيته نابعة من قداسته وألوهية مصدره، لكنه رغم ذلك يظل نصا لغويا ينتمي لثقافة خاصة. الثاني، محاولة تحديد فهم "موضوعي" للإسلام. ويتساءل الباحث: ما هو الإسلام؟ والسؤال يكتسب مشروعيته من تلك الفوضى الفكرية التي تسيطر على المفاهيم الدينية، نتيجة اختلاف الرؤى والتوجهات في الواقع الثقافي المعاصر ونتيجة أيضا لتعدد الاجتهادات والتأويلات في التراث من جهة أخرى. ولا يزعم الباحث أنه يمتلك الحقيقة، ولكنه بتواضع العالِم يرى أن هذه الدراسة بداية للبحث العلمي في مجال شائك (ص 18-23).
منهج الدراسة
يوضح الباحث بجلاء أن منهج الدراسة ينطلق من مجموعة الحقائق التي صاغتها الثقافة العربية حول النص القرآني من جهة. كما أنها تنطلق من المفاهيم التي يطرحها النص ذاته عن نفسه من جهة أخرى. إن النص في حقيقته وجوهره منتَج ثقافي، والمقصود بذلك أنه تشكّل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاما. إن ألوهية مصدر النص لا تنفي واقعية محتواه ولا تنفي من ثم انتماءه إلى ثقافة البشر. إن المدخل العلمي لدرس النص القرآني هو مدخل الواقع والثقافة، الواقع الذي ينتظم حركة البشر المخاطَبين بالنص وينتظم المستقبِل الأول للنص وهو الرسول، والثقافة التي تتجسد في اللغة. إن العلاقة بين الثقافة والنص علاقة جدلية معقدة، وللكشف عن هذه العلاقة تعتمد الدراسة المدخل اللغوي؛ وهو المنهج الوحيد الممكن من حيث تلاؤمه مع موضوع الدرس ومادّته. ويخلص الباحث إلى إيضاح يراه مهما، وهو أن حديثه عن دور الواقع والثقافة في تشكيل النصوص يمثل نقطة الانفصال بين منهج هذه الدراسة والمناهج الأخرى، مؤكدا أن لا تعارض بين تطبيق المنهج اللغوي -منهج تحليل النصوص- على القرآن وبين الإيمان بمصدره الإلهي (ص 24-28).
الباب الأول: النص في الثقافة (التشكّل والتشكيل)
مفهوم الوحي
إن الوحي مفهوم دالّ في الثقافة سواء قبل تشكّل النص أم بعد تشكّله. الاسم دال في إطار اللغة العربية قبل القرآن على كل عملية اتصال تتضمن نوعا من "الإعلام" وشرط هذا الإعلام أن يكون خفيا سرّيا من خلال شفرة خاصة مشتركة بين المرسِل والمستقبِل. يحلل الباحث الأساس الثقافي لظاهرة الوحي الديني، فيشير إلى ارتباط ظاهرتي الشعر والكهانة بالجنّ في العقل العربي وما ارتبط بهما من اعتقاد العربي بإمكانية الاتصال بين البشر والجن، فالوحي جزء من مفاهيم الثقافة، ونابع من مواصفاتها وتصوراتها.
ويتحدث الباحث عن الوحي بالقرآن، فيشير إلى أن اتصال الله بالبشر أو كلام الله للبشر له طرائق محددة عبّر عنها النص وهي: الوحي، والكلام من وراء حجاب، والوحي غير المباشر عن طريق الرسول المَلَك الذي يوحي للمستقبِل. وفي معرض التساؤل هل كان الاتصال بين جبريل والرسول وحيا بمعنى الإلهام أو وحيا بالقول. يتصدى الباحث للإجابة التي تقول أن المنزّل هو اللفظ والمعنى وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به؛ فيرى أن هذا الرأي يتصور وجودا خطّيا سابقا للنص في اللوح المحفوظ. ويرد على هذا التصور باعتباره إهدارا لجدلية العلاقة بين النص والواقع الثقافي، وأدّى هذا التصور الأزلي للنص إلى نتيجتين هامتين هما: المبالغة في قداسة النص، والإيمان بعمق دلالته وتعمق مستوياتها، وتعدد مستويات الدلالة وارتباطها بالأصل الإلهي (ص 42-43).
ويتوقف الباحث عند كلمة "القرآن" هل هي مصدر من قرأ بمعنى ردّد أو من قرأ بمعنى جمع. الباحث يأخذ المعنى الأول لأن النص تشكّل من خلال ثقافة شفاهية لم يكن للتدوين فيها دور يُذكر. إن النص في إطلاقه هذا الاسم على نفسه ينتسب إلى الثقافة التي تشكل من خلالها، ولكنه في نفس الوقت يفرض تميّزه عنها. أطلق على نفسه اسم الكتاب، وهو أول نص مدون في تاريخ الثقافة كما أنه حلقة فاصلة في تاريخ الثقافة بين رحلتي الشفاهية والتدوين. إن التنزيل هو رسالة السماء إلى الأرض، ولكنها ليست رسالة مفارقة لقوانين الواقع بكل ما ينتظم هذا الواقع من أبنية، وأهمها البناء الثقافي.
المتلقي الأول للنص
كان محمد المستقبِل الأول للنص ومبلّغه جزءا من الواقع والمجتمع. كان ابن المجتمع ونتاجه. الفكر الديني السائد حوّله إلى حقيقة مثالية ذهنية مفارقة للواقع والتاريخ وجعل منه إنسانا معزولا عن المجتمع والواقع، يعيش هموما مفارقة مثالية ذهنية. تم أيضا تحويل النص من توجهه إلى المخاطَب والمخاطَبين لكي يكون نصا دالّا على المتكلم بتحويل المخاطَب الأول إلى راهب متبتل، وصارت مهمة المخاطَبين محاولة الوصول إلى المتكلم من خلال النص من جهة، ومن خلال سلوك طريق التبتل والانقطاع عن العالم تقليدا للمخاطَب الأول. وصارت الرسالة ذات ظاهر وباطن وذات دلالة مركبة معقدة لا يفهمها إلا القليل.
وليس معنى القول بأن محمدا ابن الواقع ونتاجه أنه نسخة كاربونية من صورة العربي الجاهلي. إن الواقع الذي ينتمي إليه محمد ليس بالضرورة هو الواقع السائد المسيطر، فالواقع يحتوي على نمطين من القيم: السائد والنقيض (ص 60). وكان حب الخلاء والتحنث في غار حراء طقسا يمارسه آخرون إلى جانب محمد وقبله (الأحناف) ولم يكن محمد معزولا عن هذه الحركة الفكرية (أي الحنيفية) وكان البحث عن دين إبراهيم في حقيقته بحثا عن الهوية الخاصة للعرب. وهي هوية يهددها: الخطر الاقتصادي ومحاصرة القوى الأجنبية. وكان البحث عن إيديولوجية تحقق مواجهة الصراعات الداخلية والخارجية متمثلا في البحث عن دين إبراهيم. وكان الإسلام تجاوبا مع حاجة الواقع، وهي الحاجة التي عبر عنها الأحناف. وكان محمد واحدا منهم. محمد لا يمثل ذاتا مستقلة عن حركة الواقع، بل إنسانا تجسدت فيه أحلام الجماعة البشرية التي ينتمي إليها.
هناك تصوُّر عن وجود خطّي سابق للنص في اللوح المحفوظ، وهذا التصور يجعله معطى سابقا مكتملا فرض على الواقع، كما أنه يؤدي إلى عزل النص عن حركة الواقع تدريجيا. يؤكد الباحث أن النصوص وإن تشكلت من خلال الواقع والثقافة تستطيع بآلياتها أن تعيد بناء الواقع ولا تكتفي بمجرد تسجيله أو عكسه آليا. للغة نوع من الاستقلال النسبي عن الثقافة التي تعبر عنها وعن الواقع الذي يفرزهما، ومن هذا الاستقلال تكتسب قدرتها على إعادة بناء الواقع. وقد أفصح الوحي لمحمد عن حقيقة الدور الذي أسند إليه. إنها مهمة تتطلب إنذار المجتمع والناس بحقيقة الفساد الذي نخر المجتمع، وبضرورة التغيير تحقيقا لأحلام المستقبل.
المكي والمدني
التفرقة بين المكي والمدني تفرقة بين مرحلتين هامتين ساهمتا في تشكيل النص، سواء على مستوى المضمون أو على مستوى التركيب (ص 75). وهذا يدل على أن النص هو ثمرة للتفاعل مع الواقع الحي التاريخي. وقد اعتمد علماء القرآن معيار المكان غالبا للتمييز بين المكي والمدني. معيار آخر للتمييز هو المخاطَبين بالنص على التغليب في كل مرحلة من المرحلتين؛ وعلامة التفرقة بينهما أن كل سورة فيها (يا أيها الناس) وليس فيها (يا أيها الذين آمنوا) فهي مكية، وهو معيار ناقص لأن مخاطبات القرآن كثيرة جدا. معيار التصنيف يجب أن يستند إلى الواقع من جهة، وإلى النص من جهة أخرى. إلى الواقع حيث أن حركة النص ارتبطت بحركته، وإلى النص من حيث مضمونه وبنائه.
التمايز القاطع بين مكي ومدني مجرد افتراض ذهني؛ فالتطور لا يحدث فجأة سواء على مستوى الواقع أم على مستوى النص، ولذلك تظل التفرقة بين مكي ومدني في النص تفرقة تقوم على خصائص عامة وليست حاسمة. ويمكن الإشارة إلى اثنتين من الخصائص الأسلوبية تساعدنا في التمييز بين المكي والمدني، أولاهما: معيار طول المدنية وقصر المكية، وهو قائم على أساسين: "الإنذار" في المكية و"الرسالة" في المدنية، ومراعاة حال المتلقي الأول من حيث تعوده على الوحي. ثانيتهما: مراعاة الفاصلة، وتحاشي المقارنة بينها وبين السجع. هذان المعياران إلى جانب معيار المضمون وارتباط حركة النص بالواقع (أسباب النزول) يمكن أن يحلّ كثيرا من الخلافات حول المكي والمدني.
ونتيجة عجز المفكر القديم -حسب رأي المؤلف- عن ربط النص بالواقع والثقافة بصفة عامة، وعن ربطه بغيره من النصوص بصفة خاصة؛ أنه راح يحاول الترجيح بين الروايات المتعارضة، فإذا تساوت عنده معايير النقد الخارجي من حيث صحة السند وصدق الرواة راح يفترض أمرين: تكرر نزول النص، ونزول النص بمكة وتأخر حكمه الشرعي في المدينة. كلا الافتراضين يراهما المؤلف يؤديان إلى شناعات، فافتراض تكرر النزول هو عجز عن مواجهة آراء السابقين. كما أن منهج التلفيق بين الروايات المختلفة يؤدي إلى تعدد المعاني بتعدد مرات النزول. وهناك علاقة تلازم بين النص والدلالة. بعض العلماء يفترض أن يسبق النصُّ الحكمَ، وهذا يعني: نصوص معطلة عن أحكامها، وافتراض أن يسبق الحكمُ النصَّ يؤدي إلى إمكانية الاتصال بدون نص.
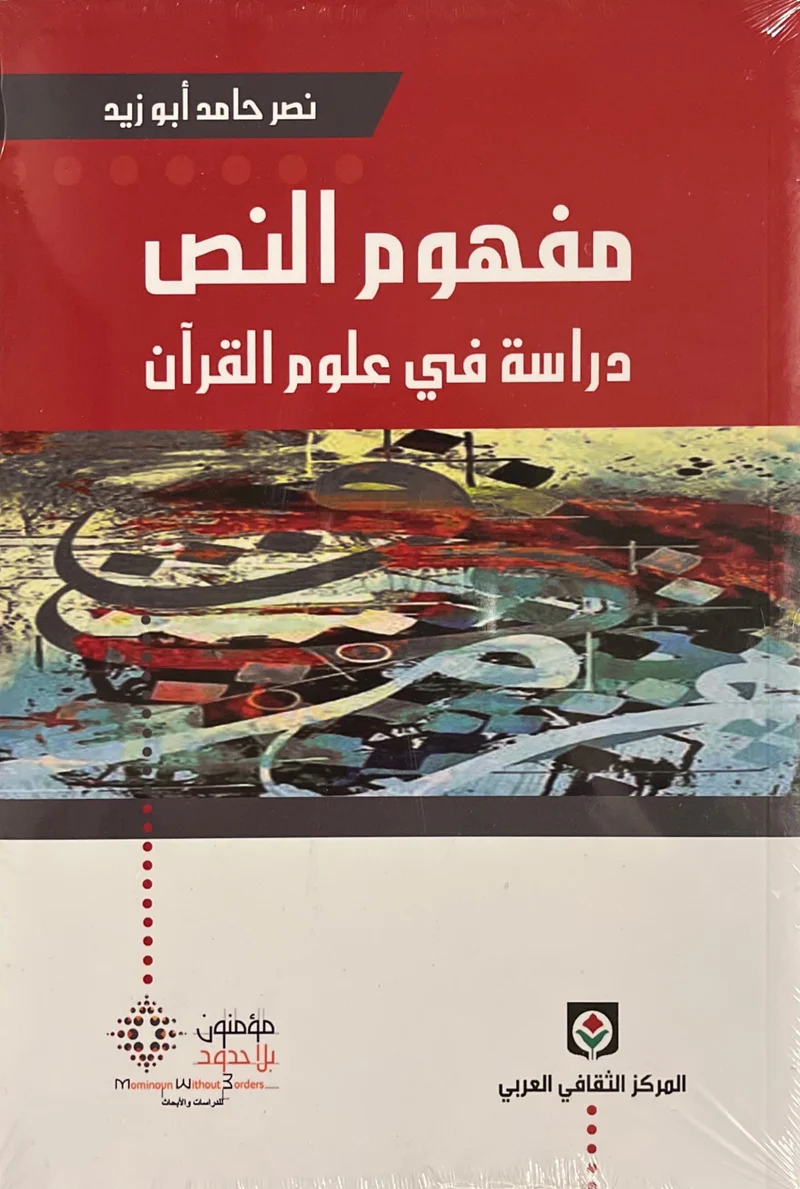
أسباب النزول
أسباب النزول من أهم العلوم الدالة والكاشفة عن علاقة النص بالواقع وجدله معه، فهو يزودنا من خلال الحقائق التي يطرحها علينا بمادة جديدة ترى النص استجابة للواقع تأييدا أو رفضا، وتؤكد علاقة الحوار والجدل بين النص والواقع. ويوضح المؤلف أن علة التنجيم هو "تثبيت الفؤاد" للمتلقي الأول، كما أن الثقافة الشفاهية يستحيل فيها استيعاب نص بهذا الطول. النص يستجيب لأحوال المرسَل إليه ليبلّغ المخاطَبين به، فالتنجيم مراعاة للوقائع والأسباب.
إن معرفة أسباب النزول تستهدف فهم النص واستخراج دلالته، ودراسة الأسباب والوقائع تؤدي إلى فهم حكمة التشريع خاصة آيات الأحكام. ومن شأن فهم الحكمة أو العلة أن يساعد الفقيه على نقل الحكم من الواقعة الجزئية وتعميمها على ما يشابهها من الوقائع بالقياس، وهذا النقل يستند إلى دوالّ في بنية النص. وإن معرفة سبب نزول كثير من نصوص القرآن على سبيل القطع واليقين ليست دائما مسألة سهلة، والقدماء تصوروا أن العلم بأسباب النزول سبيله النقل والرواية ولا مجال فيه للاجتهاد. وتبقى معرفة أسباب النزول مسألة اجتهادية، ويرى المؤلف أنه لابد للباحث المعاصر من الترجيح بين الروايات استنادا إلى مجمل العناصر والدوالّ الخارجية والداخلية المكونة للنص.
وتوقف الباحث عند تكرار نزول الآية، وتعدد الآيات عند السبب الواحد، فرأى أن الترجيح بين الروايات أدّى إلى افتراضات ذهنية غايتها الجمع بين الآراء والروايات لصدورها عن صحابة وتابعين. هناك افتراضان: تعدد النصوص استجابة لواقعة واحدة، وتكرار نزول الآية لأسباب مختلفة، كلاها يؤدي إلى الفصل بين النص ودلالته، ويؤدي إلى القضاء على مفهوم النص ذاته (ص 97-115).
الناسخ والمنسوخ
ظاهرة النسخ تعتبر أكبر دليل على جدلية العلاقة بين الوحي والواقع. ويرى الباحث أن ظاهرة النسخ تثير في وجه الفكر الديني إشكاليتين يتحاشى مناقشتهما أولهما: كيف يمكن التوفيق بين ظاهرة النسخ وبين الإيمان بوجود أزلي للنص. ثانيهما: إشكالية جمع القرآن في عهد أبي بكر، والذي يربط بين النسخ ومشكلة الجمع، ما يورده علماء القرآن من أمثلة قد توهم أن بعضه نسي من الذاكرة الإنسانية. ويعتمد تحديد معنى النسخ على نصين من القرآن: النص المكي (سورة النحل، الآيات 98-103) والنص المدني (سورة البقرة، الآيات 105-108) والمهم في تحديد الناسخ من المنسوخ ترتيب النزول، لا ترتيب التلاوة. وذلك يعتمد أساسا على معرفة تاريخية بأسباب النزول وبترتيب نزول الآيات، وهو أمر ليس سهلا.
إن وظيفة النسخ هي التيسير والتدرج في التشريع، ويشير الباحث إلى أنماط النسخ الثلاثة وهي: الآيات التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، الآيات التي نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، الآيات التي نسخ حكمها وتلاوتها معا. ولا يسلم القدماء من الخطأ في فهم ظاهرة النسخ لعدم اتخاذ موقف نقدي من روايات الناسخ والمنسوخ. إن ظاهرة نسخ التلاوة سواء بقي حكمها أم نسخ تؤدي إلى القضاء على التصور بأزلية النص في اللوح المحفوظ. وهناك مرويات كثيرة عن سقوط أجزاء من القرآن ونسيانها. وهناك افتراض أن الروايات مكذوبة، ولم يسقط شيء من القرآن (ص 117-134).
الباب الثاني: آليات النص
الإعجاز
البحث في قضية الإعجاز هو بحث عن السمات الخاصة للنص والتي تميزه عن النصوص الأخرى في الثقافة، وتجعله يعلو عليها ويتفوق. إن المعجزة التي هي دليل الوحي لا يجب أن تفارق حدود الإطار الذي تتميز به الثقافة التي ينزل بها الوحي، فالعرب الذين نزل فيهم القرآن كان الشعر مجال تفوقهم، لذلك كانت المعجزة نصا لغويا هو ذاته نص الوحي. والنص القرآني يتشابه مع الشعر من حيث ماهيته، أي من حيث كونه اتصالا، ويخالفه من جوانب شتّى. وأراد النص أن يدفع عن نفسه صفة الشعر لأسباب ترتبط بماهية الشعر من حيث المصدر والوظيفة، وأراد أن يدفع عن محمد صفة الشاعرية لأن وظيفة الشاعر مغايرة لوظيفة محمد. إن النص غير منعزل عن الواقع فلا حرج في فهم النص على ضوء النصوص الأخرى خاصة الشعر.
ومن أهم الفروق الأسلوبية بين المكي والمدني مراعاة الفاصلة (أي السجع) بين الآيات مما يؤكد تماثل النصوص مع النصوص الأخرى في الثقافة. ومحاولة القدماء سلب صفة السجع من القرآن تستهدف التفرقة بين الكلام الإلهي والكلام الإنساني، والفصل التام في النهاية أدى إلى تحويل النص إلى شيء مقدس. ويرى المؤلف أن الفاصلة التي يحرص عليها النص في المرحلة المكية تمثل علاقة بين النص وبين نمط آخر من النصوص في الثقافة، أما في المدنية فيغلب عليها الخروج على نسق الحرص على الفاصلة.
وعن الإعجاز خارج النص ترى بعض التفسيرات انفصال الدالّة عن المدلول في إعجاز الوحي في الإسلام. والمعجزة في رأيهم لا تنبع من طبيعة القرآن الخاصة بوصفه نصا لغويا، بل تنبع من عجز العرب المعاصرين له عن الإتيان بمثله بحكم تدخل الإرادة الإلهية (رأي النظّام)؛ بينما يؤكد (الباقلاني) أن إعجاز القرآن كامن داخله، في نظمه وتأليفه، ويجعل معيار الإعجاز "العجز" بمعنى عدم الوصول إلى إمكانية فهم سرّ الإعجاز. أما المعتزلة فقد حددوا الإعجاز على أنه قائم على أساس اكتشاف قوانين عامة يمكن للعقل البشري تقبلها. والفصاحة هي سرّ الإعجاز عند أبي هاشم الجبائي، ويمكن تلمسها في التركيب اللغوي، ولا بد من حسن المعنى وجزالة اللفظ لاعتبار النص فصيحا (ص 137-157).
المناسبة بين الآيات والسور
علم المناسبة يبحث في أوجه الترابط بين الآيات والسور في ترتيب التلاوة. وهو علم أسلوبي بمعنى أنه يهتم بأساليب الارتباط بين الآيات والسور. إن العلاقات أو المناسبات بين أجزاء النص ليست في حقيقتها إلا وجها آخر للعلاقة بين عقل المفسر أو القارئ وبين معطيات النص، المفسر يكتشف جدلية أجزاء النص من خلال جدله هو مع النص (ص 161). يرى الباحث أن ثمة علاقات بين السور لا تحتاج قدرا من التأويل، بل تعتمد على وجود نوع من الترابط اللغوي أو تعتمد على التكرار اللغوي بين لفظ في آخر السورة ولفظ في أول السورة التي تليها، ويدعم رأيه بالأمثلة.
الغموض والوضوح
يرى الباحث أن جدلية الغموض والوضوح من أهم خصائص النص في الدراسات النقدية الحديثة. ومن أهم خصائص النصوص الأدبية أن يخالف النص نفسه. وللنص آليات في مخالفة ذاته ترتبط بجدل الواقع معه مِن خلال فعل "القراءة"، وإنتاج الدلالة فعل مشترك بين النص والقارئ فيكون فعلا متجددا بتعدد القرّاء واختلاف ظروف القراءة.
وفي العلاقة بيم المنطوق اللفظي للنص وبين المفهوم الذهني الناتج عن هذا المنطوق يتبلور مفهوم للنص يقرن بينه وبين الوضوح بحيث يصبح "النص" هو التركيب اللغوي الذي يتطابق فيه المنطوق مع المفهوم تطابقا تاما. إن فعل القراءة - ومن ثم التأويل - لا يبدأ من المعطى اللغوي (أي المنطوق) بل يبدأ قبل ذلك من الإطار الثقافي الذي يمثل أفق القارئ الذي يتوجه لقراءة النص (ص182).
ثم يوضح المقصود بالمجمل أي الغامض ويستعرض أشكالا عديدة للإجمال المؤدي إلى الغموض. والمبدأ الذي طرحه المفسرون أن الغموض الراجع إلى الإجمال يمكن الوصول إلى دلالته بالعودة إلى النص ذاته في مكان آخر، فالمجمل في موضع له بيان في موضع آخر. وفي كثير من أجزاء النص يحدث نوع من الاختلاف الذي يبرز من خلال "التكرار" ولكنه تكرار لا يعيد نفس الشيء، بل تكرار يطرح جديدا، فالاختلاف لا يؤدي إلى تناقض بل دالّ على الإعجاز لدلالته على قدرة النص على التصرف دون الوقوع في التكرار الحرفي. إن نفي الاختلاف الذي يوهم التناقض ليس نفيا للاختلاف، بل نفي للتناقض الذي يمكن أن يوهمه هذا الاختلاف. وعن الحروف المقطعة في أوائل السور فإن المنطوق في حالة الحروف المقطعة غير دالّ، أي ليس له مفهوم مباشر أو غير مباشر. ويناقش الباحث بعض تأويلات علماء القرآن للحروف المقطعة، ويخلص إلى أن النص خالف بين ذاته وبين غيره من النصوص من جهة، وخالف بين أجزائه من جهة أخرى، وهذه المخالفة آليّة من آليّات النص حقق بها تميزه وقدرته على التفاعل مع الثقافة في المكان والزمان.
العام والخاص
يؤكد العلماء أن النصوص وإن نزلت عند سبب خاص تتجاوز من حيث دلالتها حدود هذا السبب الخاص، وتساءلوا هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، وهو خلاف فقهي يرتبط بآيات الأحكام دون غيرها من الآيات. واهتمام الفقهاء والأصوليين باكتشاف الطرائق التي يمكن أن يستجيب بها النص لمتغيرات الواقع في حركته المتطورة عبر التاريخ هو العامل الأكبر وراء التركيز على "عموم اللفظ" دون "خصوص السبب". ثم يشير الباحث إلى آليّات العموم ويشرحها، ويرى أن الانتقال من الخاص إلى العام انتقال دلالي يتحقق باستخدام بعض آليّات اللغة ولكنه لا ينفي علاقة النص بالواقع. ثم يتناول آليّات الخصوص، فيشير إلى وسائل لغوية تحول العموم إلى خصوص، أي تخصص الدلالة العامة للنصوص. ويناقش علاقة أجزاء النص بعضها بالبعض الآخر من منظور العموم والخصوص. وما ورد في النصوص مطلقا قد يأتي في نص آخر ما يقيّد هذا الإطلاق، وما ورد مطلقا يظل على إطلاقه وعمومه ما لم يكن هناك نص يقيّد هذا الإطلاق (ص 195-217).
التفسير والتأويل
التأويل هو الوجه الآخر للنص. ويرى الباحث أن "التأويل" تحوّل إلى مصطلح مكروه لحساب مصطلح "التفسير" في الفكر الديني الرسمي، ووراء هذا التحويل محاولة مصادرة كل اتجاهات الفكر الديني المعارضة سواء على مستوى التراث أم على مستوى الجدل الراهن في الثقافة. ويرى أن وصم الفكر السائد للفكر النقيض بأنه فكر تأويلي يستهدف تصنيف أصحاب هذا الفكر في دائرة مَن يستهدف إثارة "الفتنة" (ص 219).
ويسهب الباحث في الاشتقاق اللغوي لكلمتيْ تفسير وتأويل. تم يوضح دلالتهما الاصطلاحية، فالتفسير يبدو خاصا بالجوانب الخارجية للنص مثل العلوم النقلية، ويجمع كل العلوم الممهدة للتأويل، وعليه يكون التفسير جزء من عملية التأويل. التأويل يرتبط بالاستنباط في حين يغلب على التفسير النقل والرواية. إن المؤول لابد أن يكون على علم بالتفسير يمكنه من التأويل المقبول للنص، وهو التأويل الذي لا يخضع النص لأهواء الذات. والاستنباط لا بد أن يستند إلى حقائق النص ومعطياته اللغوية. ثم يشير إلى آليات التأويل، حيث يتحتم على المفسر الوقوف عند علوم القرآن وعلم اللغة.
الباب الثالث: تحويل مفهوم النص ووظيفته
يتابع المؤلف التحول الذي أصاب مفهوم النص ووظيفته، وتوقف عند نص أبي حامد الغزالي، والدور الخطير الذي قام به في صياغة المفاهيم والتصورات التي شاعت واستقرت في مجال الفكر الديني، وتستهدف دراسة الغزالي حسب رأيه الكشف عن أسباب بداية عزل النص عن الواقع وعن حركة الثقافة والكشف عن جذور كثير من الأفكار والمفاهيم الشائعة في الخطاب الديني المعاصر. تصورات الغزالي للنص تنشأ من منطلقين أحدهما أشعري كلامي ينطلق من حقيقة تصور الأشاعرة للنص بوصفه صفة من صفات الذات الإلهية، وثانيهما صوفي غنوصي يتحدد منطلقه الصوفي من حصر غاية الوجود الإنساني تحقيق الفوز في الآخرة. ومن هذين المنطلقين يتحدد مفهوم الغزالي للنص وطبيعة مشروعه الفكري.
يبين الغزالي أقسام القرآن وعلومه، ويصنف العلوم إلى علوم الدين وعلوم الدنيا. ومن خلال هذا التصور الثنائي يتم تصور النص، كما يتم تصنيف العلوم التي يمكن استخراجها منه. وعنده ثنائية أخرى هي: الظاهر والباطن، فللقرآن ظاهر وباطن على مستوى المعنى والبناء في نسق النص. الباطن هو الحقائق، والظاهر هو الصدف والقشر. واللغة في هذا التصور مجرد وسيط تؤدي فعالياته إلى اكتشاف القشرة الخارجية للنص. وصارت معرفة الله هي غاية الغايات، وأصبح الوصول إليه هو الهدف الأسمى من الحياة ومن المعرفة والعلم. وصارت الآيات الدالة عل معرفة الله هي سرّ القرآن، وصار العلم الناتج عنها هو العلم الأول في طبقة سمّاها علوم اللباب (ص 251).
ويفرق الغزالي بين عالم الحس والشهادة وعالم الغيب والملكوت. عالم الملكوت هو الحقيقي وهو بالنسبة لعالم الشهادة بمثابة اللب بالنسبة للقشر. وإذا كانت علوم الدين تنتمي إلى عالم الغيب والملكوت فإن علوم الدنيا تنتمي إلى عالم الحس والشهادة؛ والغزالي يجعل القرآن نبع العلوم كلها، الدنيوية والأخروية. إن السلوك إلى الله عند الغزالي لا يكمن في الاستجابة لأوامر الوحي، بل في التبتل والانقطاع إلى الله. والانتقال من عالم الملك والشهادة إلى عالم الغيب والملكوت، ويتم بالروح والقلب دون الجسد عبر الخيال.
وبعد أن يستشهد الباحث بنصوص الغزالي يخلص إلى أن النص يتحول إلى سرّ مقفل، وهذا السر بمثابة شفرة خاصة لا يطمح الإنسان العادي الوصول إليه إلا بشق الأنفس. ويرى الغزالي أن القرآن بحر ساحله علوم القشر والصدف، وأعماقه الطبقة العليا من علوم اللب؛ والقرآن في مفهومه هو البحر المحيط في أعماقه الجواهر لا يعثر عليها إلا الغواصون، وهم السالكون، ويستخدم لتصنيف علوم القرآن ثنائية القشر واللب أو الصدف والجواهر تصنيفا حقيقيا حرفيا. وهو يتعامل مع اللغة بوصفها رموزا، لا بوصفها نظاما رمزيا؛ أي مجموعة من الألفاظ ذات بعدين أحدهما حقيقي هو المعنى الروحي، والآخر قشرة خارجية أو رمز، وهو الدلالة اللغوية المعروفة.
موقف الغزالي من التأويل حسب رأي المؤلف يتسم بِكثير من التناقض سببه الجمع بين النهج الأشعري، وهو نهج كلامي تلفيقي، وبين النهج الصوفي، وهو نهج حدسي ذوقي. وقد كان على الغزالي أن يجمع بين هذين الشقين الفكريين من خلال ثنائية الخاصة والعامة، حيث يكون في العقائد الأشعرية غُنْية للعوام يكفي لتحقيق الخلاص الأخروي بينما يستطيع الخاصة تجاوز أفق السلامة والرضا بالنعيم المادي إلى أفق نعيم المعرفة والفناء في المطلق (ص 282). والغزالي يفضل بعض أجزاء النص، فهو يرى أن آياته وسوره تتفاضل من حيث مضمونها؛ والاعتماد الكمّي في نظره دليل على الغفلة وقلة المعرفة، أما المعيار الكيفي فهو المعيار الضروري لقياس مستويات النص وإدراك تفاوتها. ويورد المؤلف نموذج شرح الغزالي لسورة الفاتحة وآية الكرسي ملحقا برسم بياني. ويحرص الغزالي بعد بيان بعض السور والآيات ذات المكانة الخاصة أن يسرد الآيات (الجواهر) الدالّة على معرفة الله في سلك واحد، ثم يضم في سلك آخر الآيات (الدرر) الدالة على الطريق المستقيم؛ وهكذا يفتت النص إلى مهم وإلى أقل أهمية، محولا النص إلى مجموعة من الأسرار الغامضة تتفاوت في أهميتها وقيمتها.
نلاحظ أن الباحث اختار الغزالي لأن خطابه ما يزال مهيمنا على الفكر الديني، لهذا اهتم بنصّه كنموذج استغرق أكثر من ستين صفحة، مدعما برسوم بيانية، مستشهدا باقتباسات كثيرة طويلة جدا من كتابه "إعجاز القرآن" وأحيانا من "إحياء علوم الدين". وقد أثارت دراسة الباحث الأدبية للنص القرآني الكثير من الجدل. وقدم الكتاب كشاهد إدانة إلى المحكمة التي حكمت ظلما بكفره وتطليقه من زوجته. واجتهد الباحث لتقديم دراسة أدبية للنص القرآني، ليسجل موقفا مما يدور في ساحة الصراع الاجتماعي في بلاده.