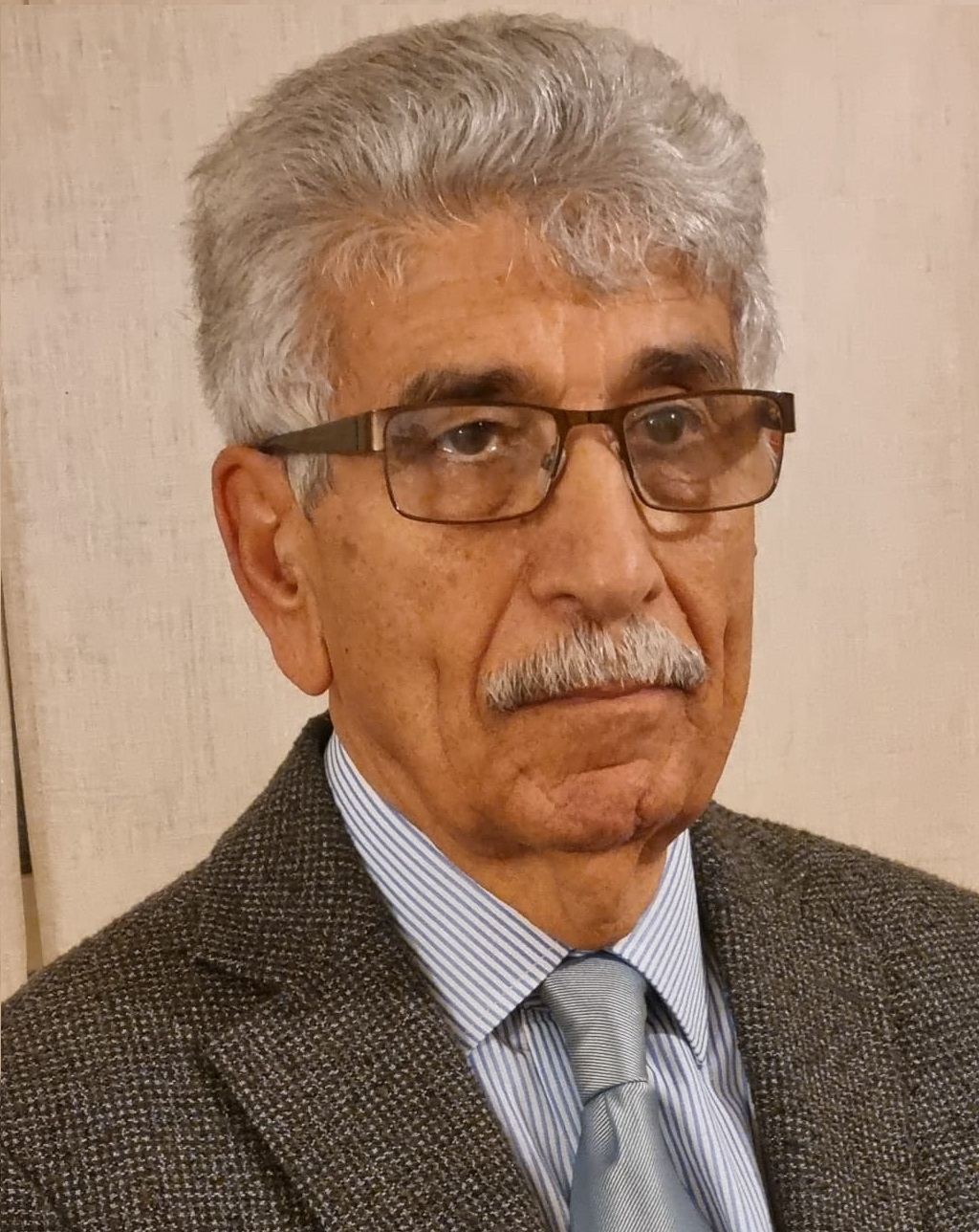
مقدمة
يثير مفهوم العولمة في الوقت الراهن، إشكاليات عديدة، ترجع إلى كثرة الكتابات التي تتناولها، وتقديم دراسات متباينة لمضمونها، تركز على آليات العولمة، وليس على مضمونها، الذي يعني التبادل الحر بكافة أنواعه (السلع، الخدمات، رؤوس الأموال، المعلومات والأفراد) عبر الحدود الوطنية بدون تدخل الدولة. إن الاختلاف في مفهوم العولمة، لا يقتصر على الباحثين والمفكرين والسياسيين، بل ماذا تعني العولمة وما هي أهدافها وتأثير تطبيقها على المواطنين في الدول الغينة والفقيرة. كل ذلك، أدى إلى خلق التباس حول حقيقة العولمة ومضمونها.
وبناء على ذلك، تحاول المقالة القاء بعض الأضواء على سمات العولمة الرأسمالية المعاصرة وتأثيرها على البلدان النامية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، استناداًعلى الوقائع الفعلية الناتجة عن التطبيق، وليس على الأهداف المعلنة من قبل قوى الهيمنة الدولية ومناصريها في الدول الوطنية أولاً. وثانياً، تناول العلاقة الجدلية بين العولمة كونها ظاهرة طبيعية نتيجة تطور العلاقات بأشكالها المختلفة بين دول وشعوب العالم، وبين العولمة الرأسمالية من خلال تتبع المظاهر الناتجة عن تطبيق العولمة في عالم القطبية الواحدة.
سيتم تناول الموضوع من خلال محورين، الاول، مقدمات تمهيدية. والثاني، مراحل العولمة المعاصرة.
المحور الاول، ملاحظات تمهيدية وتعريف العولمة
أولاً، ملاحظات تمهيدية
- تزامن مع بروز ظاهرة العولمة بصيغتها الأمريكية، الترويج بكثافة لكثرة من المفاهيم مثل الديمقراطية، حقوق الإنسان، الحرية، التعددية، المجتمع المدني، التدخل الإنساني، الدولة العميقة، العلمانية، صراع الحضارات، نظرية الفوضى الخلاقة، نهاية التاريخ، الليبرالية الجديدة، الكوكبة، التدويل والتكامل وغيرها، وقد كان الهدف من تصدر هذه المفاهيم وكثرة الكتابة عنها والدعاية لها من الإعلام المعولم ومراكز الأبحاث والمفكرين والباحثين المرتبطين بالنخب الحاكمة في البلدان الرأسمالية الغربية، هو حرف الانتباه عن مناقشة التأثيرات السلبية التي تتركها العولمة الرأسمالية على شعوب العالم.
- تمثل ظاهرة العولمة، تطوراً طبيعياً لحركة التاريخ البشري نحو التواصل والتكامل، وقد مر تطورها التاريخي بمراحل عديدة بدأت مع تكامل مفهوم الدولة القومية في أوروبا في منتصف القرن الثامن عشر والحاجة إلى تنظيم العلاقات الدولية، وتنظيم الاتصالات والتجارة التي ازدهرت بفضل نتائج الثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا، وما نتج عنها من زيادة الانتاج الصناعي، وتعاظم الثروة الاجتماعية وزيادة عدد السكان وظهور طبقات اجتماعية جديدة، البرجوازية والطبقة العاملة، وبناء على ذلك ينبغي تحليل الطابع المتناقض للعولمة الرأسمالية، باعتبارها نظام تاريخي ينمو ويتطور، ويرتبط تطبيقها وتطورها بالظروف الملموسة التي تجري فيها.
- اما العولمة بنمطها الحالي، وهدفها المرتبط بهيمنة الغرب على العالم، فإن نشأتها ارتبطت بمساعي الدول الغربية للسيطرة على العالم واستعماره "المرحلة الاستعمارية" 1880 ـ 1925، حين أكملت الدول الأوربية والولايات المتحدة سيطرتها على أغلب الشعوب في أمريكا اللاتينية وأسيا وأفريقيا(1).
- لم يكن مفهوم العولمة جديداً في الفكر السياسي والاقتصادي، حيث تم تناوله من قبل عدد من المفكرين من توجهات فكرية مختلفة، ومنهم كارل ماركس، الذي أشار إلى فكرة عولمة نضال الشغيلة، بطرحة شعار "يا عمال العالم اتحدوا" القائم على وحدة مصالح الشغيلة من مختلف الأقطار، ردا على توحيد نشاط الرأسماليين على الصعيد العالمي، وتحليله لطبيعة تراكم رأس المال على الصعيد الدولي.
- ومن حيث المضمون، نرى أن كافة الإيديولوجيات الشمولية، تدخل ضمن مفهوم العولمة على سبيل المثال شعار تيار الإسلام السياسي، الإسلام هو الحل، وصلاحيته لكل زمان ومكان، وكذلك فكرة الشيوعية صالحة لكل مجتمع. وعلى الصعيد النظري، طرحت الماركسية، فكرة زوال الدولة لصالح تنظيم دولي خالي من مؤسسة الدولة، وقبل ان تزول الدولة طرحت الماركسية، ضرورة وحدة نضال الشغيلة في العالم لتحقيق المجتمع الخالي من الطبقات، ويمثل تأسيس الأممية الشيوعية الاولى تجسيدا لهذ المسعى. وكذلك يمثل توجه الشركات الرأسمالية من مختلف البلدان، لتوحيد نشاطها من أجل الهيمنة على الشعوب والدول، وكذلك نظرية نهاية التاريخ، لفرنسيس فوكاياما، فكلها تمثّل تعبيرات مختلفة عن ظاهرة وجوهر العولمة في الظروف المعاصرة.
- هناك التباس فيما يخص الأساس الاقتصادي الذي تستند عليه العولمة، أساسه قام على عدم التفريق بين رأس المال "بوصفه علاقة اجتماعية" وتدويل رأس المال بوصفه "تدويل لملكية رأس المال"(2). فالأول، يعني أن التدويل قائم على علاقة العمل برأس المال. أما الثاني، فانه يدل على اشتراك رأس مال عدة دول في ملكية رأس المال. إن هذا التمييز يساعد على تبين خطأ الطروحات التي تزعم ان العولمة مفيدة بالمطلق لكل دول العالم بالاستناد على المفهوم القائل بالملكية الدولية لرأس المال، وبالتالي فأن منافع ومضار العولمة تشمل جميع دول العالم حسب حصتها من ملكية رأس المال الدولي، وبذلك يجري التمويه على تدويل الاستغلال الذي تتسم به العولمة الرأسمالية، من خلال حصر تدويل رأس المال بالعلاقة بين رأسماليين من دول متعددة.
- إن ظاهرة العولمة ينبغي أن تفهم كما هي في الواقع، وليس كما يروج لها منظرو الليبرالية الجديدة في أبحاثهم ووسائل الإعلام الليبرالية، باعتبارها مسألة ضرورية مرتبطة بالتطور العالمي ونمو الاتصالات بين الشعوب والتطور التكنولوجي ونمو المصالح الاقتصادية المشتركة، والغاء الحواجز بين الأسواق، بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، وبالتالي أصبحت العولمة هي نتاج طبيعي لوحدانية شكل التطور الرأسمالي على الصعيد العالمي، في بداية تسعينيات القرن الماضي. وبدا الترويج لفكرة "المقاومة المستحيلة" بمعنى أن الوقوف بمواجهة العولمة الرأسمالية هو وقوف بوجه التطور البشري. وقد تم التعبير فلسفياً عن هذا بفكرة نهاية التاريخ التي طرحها المفكر الليبرالي، فرنسوا فوكوياما، قبل أن يتخلى عنها لاحقاً. وبحسبي إن ذلك تكرار لفكرة هيغل الشهيرة: كل ما هو قائم هو عقلاني.
- تعتمد العولمة الرأسمالية في تنفيذ اهدافها على مجموعة من المؤسسات الدولية الخاضعة لهيمنة الدول الرأسمالية الكبرى، بشكل مباشر، ومن اهمها: منظمة التجارة الدولية "الجات"، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للأنشاء والتعمير، الشركات متعدية الجنسية، الاتحاد الأوروبي، حلف شمال الأطلسي، منتدى دافوس، نادي باريس، ومجموعة الدول السبع، يضاف لها الصحافة المعولمة ومنظمة الامم المتحدة ومؤسساتها التي تسيطر عليها الدول الغربية، بشكل غير مباشر.
ثانياً، تعريف العولمة
هناك اختلاف كبير بين المفكرين والباحثين ومعاهد الأبحاث حول تعريف العولمة، يرجع إلى اختلاف المواقف الفكرية والسياسية والأهداف التي يخدمها التعريف. هناك نوعان من التعريفات، الأول، يشمل تعريفات نظرية عامة مجردة تبتعد عن تبيان أهداف العولمة الرأسمالية الحقيقة، وتركز على آليات العولمة المعلنة. والنوع الثاني، هو الذي يكشف عن الأهداف الحقيقية للعولمة الرأسمالية باعتبارها وسيلة لمواصلة هيمنة الدول الرأسمالية الغربية على البلدان الضعيفة التطور، بعناوين جديدة.
وهنا أدرج بعضاً من النوع الأول:ـ
- العولمة هي أيديولوجية الليبرالية الجديدة(3).
- تعريف سمير أمين: العولمة ستار تكمن الرأسمالية الهمجية من ورائه(4).
- تعريف لطفي حاتم: العولمة هي تعبير عن الطور الجديد من التوسع الرأسمالي، بترابط وتناقض مستويات بيئته الاقتصادية والسياسية(5).
- تعريف شائع، تروج له معاهد أبحاث الليبرالية الجديدة وكتابها يقول: العولمة سيرورة محققة ناتجة عن تدويل العمليات الأساسية للإنتاج وإعادة الإنتاج والعمل والأسواق والتوزيع"(6).
- تعريف مجمع اللغة العربية: جعل الشيء عالمي الانتشار في مداه وتطبيقه. وهذا اتجاه يعتمد على الإبداع العلمي والتطور الثقافي والصناعي وثورة الاتصالات، بحيث تفرض الدول القوية المتقدمة أنماطها في مختلف المجالات، وتطمس الهوية الذاتية للأمم الضعيفة(7).
وهناك كثير من التعريفات من النوع الثاني اذكر منها:
1, " التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة ودون حاجة إلى إجراءات حكومية"(8).
- تعريف توم جي بالمر ( tom G Palmer ) من معهد كيتو بواشنطن: العولمة عبارة عن تقليل أو الغاء القيود المفروضة من قبل الدولة على كل علميات التبادل التي تتم عبر الحدود وازدهار ظهور النظم العالمية المتكاملة والمتطورة للإنتاج والتبادل الناتجة عن ذلك"(9).
- تعريف العولمة الملموس: حرية فئة كبار رجال الأعمال في ان تقيم منشآتها اينما أرادت، حينما أرادت وان تنتج ما تريد وان تحصل على موادها وان تبيع أينما شاءت، والا تواجه سوى أقل ما يمكن من التزامات كقانون العمل والتعويضات الاجتماعي"(10).
إجمالاً، يمكن تكثيف معنى العولمة الرأسمالية بانها: تعبير عن شكل التوسع الرأسمالي أو وسيلة التوسع الرأسمالي الذي يتلاءم مع فترة القطبية الواحدة، للهيمنة على العالم ونهب ثروات الدول النامية. وبهذا المعنى تعتبر العولمة استراتيجية مشتركة من الدول الرأسمالية الغربية الكبرى، للهيمنة على العالم، في ظل نظام القطبية الواحدة الذي تقوده الولايات المتحدة.
المحور الثاني، مراحل تطور العولمة الرأسمالية المعاصرة
لقد مرّ تطور العولمة الرأسمالية بعدة مراحل بناء على المراحل التي تطورت فيها الرأسمالية الغربية ومساعيها للهيمنة والأسلوب الذي اتخذته لإخضاع دول العالم. وبخصوص العولمة المعاصرة، يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل(11):
الأولى، بدأت بمساعي الولايات المتحدة بتعزيز نفوذها في أمريكا اللاتينية والدول الأوروبية الأكثر تطوراً ( بريطانيا، المانيا، فرنسا ، إيطاليا ، إسبانيا والبرتغال ) لتوسيع سيطرتها خارج أوروبا، الذي اكتمل بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى 1918، حيث تمت السيطرة على كامل قارة أفريقيا ومعظم آسيا، وهنا تحولت العولمة من طباعها الذي ينسجم مع التطور الطبيعي للتكامل بين الشعوب والدول، إلى نمط الهيمنة على البلدان والشعوب الضعيفة خارج أوروبا والولايات المتحدة، ومن أجل اضفاء شرعية على الاستعمار الغربي، ظهرت عصبة الأمم 1920، كتنظيم دولي ينظم العلاقات الدولية وتحقيق السلم والأمن الدوليين، كأهداف رئيسية معلنة، ولكن وقوعها تحت تأثير الدول الاستعمارية الأوروبية والولايات المتحدة واستغلالها لمصالحها الخاصة على حساب شعوب العالم الضعيفة، فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة ومنع نشوب الحرب العالمية الثانية.
المرحلة الثانية، ظهرت هذه المرحلة، بعد الحرب العالمية الثانية، التي أدت نتائجها إلى نشوء نظام جديد للعلاقات الدولية ثنائي القطبية، المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي، أدى إلى تأسيس منظمة الامم المتحدة 1945 لتكون بديلاً لعصبة الأمم، هدفها تعزيز التعاون الدولي والمحافظة على السلم والامن في العالم. وقد استطاعت المنظمة، على الرغم من الحرب البادرة والتنافس بين المعسكرين الإشتراكي والرأسمالي، تحقيق انجازات هامة، تمثلت بمساعدة عدد كبير من المستعمرات لتحقيق استقلالها الوطني وتكوين دولها المستقلة، وانشاء العديد من المنظمات الدولية التي استطاعت تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدات المختلفة للدول ضعيفة التطور.
لقد تم الحد من المظاهر السلبية للعولمة، خلال فترة الحرب الباردة، تحت تأثير الصراع بين المعسكر الاشتراكي والرأسمالي والدور الفعال لحركة التحرر الوطني التي استطاعت التخلص من السيطرة الاستعمارية وتكوين العشرات من الدول المستقلة سياسيا عن قوى الهيمنة الغربية. وهنا أشير إلى العديد العوامل التي اضعفت من قدرة قوى العولمة الرأسمالية على فرض هيمنتها على بقية دول العالم(12)، ومن أهمها:
- توازن القوى على الصعيد العالمي، لم يسمح للدول الرأسمالية الكبرى بالهيمنة على العالم.
- الدعم، السياسي والاقتصادي، الذي تقدمه دول المعسكر الاشتراكي للدولة النامية، عزز من قدرتها على مقاومة مشاريع الهيمنة الغربية.
- فعالية القوى الديمقراطية واليسارية في الدول الرأسمالية، المعارضة لسياسة النخب الحاكمة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول النامية.
- قوة تنظيم الطبقة العاملة على الصعيد العالمي ونشاطها الفعال للدفاع عن حقوق العمال والشغيلة بشكل عام.
- كما كان للتنافس المتعدد الأشكال بين المراكز الرأسمالية الكبرى، تأثيره الإيجابي على قدرة دول العالم الثالث في مقاومة ضغوط الدول الرأسمالية الكبرى.
المرحلة الثالثة، بدأت بعد انتهاء الحرب الباردة، نتيجة انهيار المنظومة الاشتراكية، المتمثّلة بالاتحاد السوفييتي ودول اوروبا الشرقية، في بداية تسعينيات القرن العشرين، حيث سار التطور التاريخي للعولمة الرأسمالية في ظل نظام القطبية الواحدة الذي تمثله الولايات المتحدة، وتحت تأثير انتصار الرأسمالية واعتبارها النظام الوحيد لتطور البشرية. وخُلق انطباع واهم لدى النخب السياسية والثقافية، خاصة الحاكمة، بان الرأسمالية هي النظام الوحيد الذي ينسجم مع التطور البشري، وأنه لا يوجد أسلوب حياة وتطور بكافة جوانبه لا يأخذ من الغرب منابعه، وادى هذا الوهم إلى ظهور كثير من النظريات التي تروج فكرة انتصار الرأسمالية النهائي على المستوى الدولي، كنظرية "نهاية التاريخ" للفيلسوف الأمريكي، فرانسيس فوكوياما، ونظرية صراع الحضارات، لصاموئيل هنتنغتون، لتدافع عن فكرة أن حضارة الغرب هي حضارة العالم(13). وبناء على سير تطور العولمة الرأسمالية خلال مرحلة القطبية الواحدة، يمكن تقسيمها إلى فترتين:
الفترة الاولى، 1990 ـ 2008
يمكن الإشارة بشكل مكثف إلى أبرز ملامح هذه الفترة، بالعناوين التالية:
- اتخذت العولمة مسارا جديدا بعد حرب الخليج الاولى 1991، حيث تم فرض الرؤية الامريكية للعولمة الرأسمالية بالقوة، مستغلة ميل ميزان القوة العسكرية لصالح الغرب، نتيجة انهيار المنظومة الاشتراكية.
- سيطرت أفكار الليبرالية الجديدة على تفكير النخب السياسية الحاكمة في الدول الرأسمالية الغربية وأصبح النهج السياسي المحافظ هو السائد في تعامل الدول الغربية مع بقية دول وشعوب العالم(14).
- بعد ان شعرت الولايات المتحدة، بأنها قائدة النظام العالمي الجديد الذي تشكل بعد نهاية الحرب الباردة، ولا توجد قوة في العالم قادرة على منافستها، شجعت سياسة الانفتاح الاقتصادي، التي أدت إلى انتعاش التجارة العالمية ونقل التكنلوجيا المتطورة إلى الدول الأخرى، الذي نتج عنه تطور عدد من البلدان في شرق أسيا "النمور الأسيوية" وظهور دول الرأسمالية الناهضة (الصين، الهند، البرازيل وروسيا)(15).
- ومن أجل اعطاء مصداقية لمزاعم العولمة الرأسمالية عن نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في العالم، قامت الولايات المتحدة باتخاذ بعض الخطوات، منها على سبيل المثال، الضغط على إسرائيل وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية لعقد اتفاقية أوسلو عام 1993 لتلبية بعض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، التدخل العسكري في الصومال عام 1992 لإيقاف الحرب الأهلية وتقديم المساعدة للتقليل من المجاعة، حيث مهد هذا التدخل لإضفاء شرعية دولية لمفهوم التدخل الإنساني الذي أصبح لاحقا سياسة معلنة من الولايات المتحدة ودول حلف الأطلسي للتدخل في النزاعات الوطنية في الدول النامية(16).
- ظهور الشركات متعدية الجنسية، التي سيطرت (500) منها على 80 % من الانتاج القومي العالمي و85% من حركة التجارة العالمية، وقدرت ثروتها بـ 20 ترليون دولار، وتتوزع مقار هذه الشركات: في دول الاتحاد الأوروبي (163) الولايات المتحدة (162) واليابان (67) وفي الصين (25) وفي كوريا الجنوبية (14) والهند (6) والبرازيل (5) شركات(17). وكان من نتائج تأثير الشركات متعدية الجنسية، الانتقال التدريجي لصناعة القرار السياسي من السلطة السياسية، الحكومة والبرلمان، إلى المؤسسات الاقتصادية الكبرى ورجال المال(18).
- زيادة الاعتماد على المنظمات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستثمار، ومؤسسة التنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، اضافة إلى منظمة التجارة الدولية، لفرض توجهات العولمة الاقتصادية على البلدان التي تتعرض لازمات مالية واقتصادية او تحتاج إلى التمويل المالي الخارجي لتطوير اقتصادها(19). في حالة فشل التوجهات السابقة أو رفض الدول النامية لها، يتم اللجوء إلى الضغوط والعقوبات الاقتصادية والتجارة غير المتكافئة التي أدت إلى تحول هذه البلدان إلى مصدر لتصدير المواد الأولية ونهب خيراتها، حيث بلغت خسائر بلدان الجنوب من التجارة غير المتكافئة مع دول الشمال حوالي (14) مرة من المساعدات التي تقدمها الدول الرأسمالية إلى الدول النامية (700 مليار الخسائر مقابل 50 مليار المساعدات)(20).
- التدخل العسكري، بما فيه الغزو العسكري، من قبل الدول الغربية في النزاعات الوطنية في الدول النامية، بهدف احكام الهيمنة عليها. على سبيل المثال، التدخل العسكري في الصومال 1992، وفي البلقان "يوغوسلافيا سابقاً" بين عامي 1992 ـ 1999 وانتهت بتقسيم يوغسلافيا إلى ست دول. والغزو العسكري لأفغانستان 2001 والعراق 2003.
- تأجيج الصراع الثقافي ضد ثقافات الشعوب غير الاوربية، تحت تأثير نظرية صراع الحضارات واستغلال أحداث 11 أيلول| سبتمبر، لخلق حالة الخوف من الإسلام لدى الشعوب الغربية.
- اتخاذ الديمقراطية وحقوق الإنسان كوسيلة لاحتواء البلدان غير المتطورة التي تعلن رفض الهيمنة الغربية والضغط على النخب الحاكمة في الدول الخاضعة لها لأحكام الهيمنة عليها، مع السعي لفرض النموذج الأمريكي، بشكل خاص، كما حدث في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، هايتي على سبيل المثال، التي تحولت إلى دولة فاشلة تتحكم فيها العصابات المسلحة وتجار المخدرات. كما أن تطبيق ديمقراطية الفوضى الخلاقة، بعد الغزو الأمريكي، لأفغانستان وللعراق، أدى إلى تفكك الدولة العراقية وانتشار الفوضى والعنف، وبالنسبة لأفغانستان، فقد عادت حركة طالبان إلى السلطة، بعد أكثر من عقدين من الاحتلال الامريكي.
- تشجيع النزاعات الإثنية في كثير من البلدان غير المتطورة، تحت شعار حقوق الأقليات، الأمر الذي أدى إلى صراعات عرقية ومذهبية وحروب أهلية في كثير من الدول ذات التعدد العرقي والإثيني، ذهب ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين وتخريب البنى التحتية ومؤسساتها الاقتصادية(21).
- استخدام الضغوط السياسية والاقتصادية لإجبار الدولة الوطنية للتخلي عن دورها الإجتماعي، واستخدام نفس الأسلوب لتفكيك دولة الرفاه الاجتماعي في شمال أوروبا، وتشجيعها للتخلي عن دورها الاجتماعي وخصخصة القطاع العام وبشكل خاص مؤسسات الخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم والخدمات العامة(22).
الفترة الثانية، العولمة بعد الأزمة المالية العالمية 2008ـ 2009
شهدت هذه الفترة أول أزمة مالية عالمية (2008 ـ 2009 ) في عصر القطبية الواحدة، وبددت الاعتقاد الذي روجت له قوى الهيمنة الدولية ومفكروها، وهو انتهاء عصر الأزمات الاقتصادية العالمية، بعد انتهاء الحرب الباردة. لقد أدت الأزمة، إلى تغيير نوعي في نهج الليبرالية الجديدة والنخب الحاكمة تمثل بتدخل الدولة في الاقتصاد الوطني، بهدف انقاذ المؤسسات المالية والشركات الكبرى المعرضة للإفلاس نتيجة لآليات المنافسة التي تؤدي إلى إزاحة الشركات التي تعجز عن المنافسة، وحسب القاعدة التي تقول: إن من يفلس يخرج من السوق. وقد كسرت الدولة الرأسمالية هذه القاعدة باتخاذها العديد من الإجراءات، من أبرزها، تقديم القروض والإعانات المالية والإعفاءات الضريبية، للشركات الكبرى والبنوك، للحد من تداعيات الأزمة المالية عليها، في حين تم تحميل المواطنين، خاصة محدودي الدخل، التبعات المالية، من خلال زيادة الضرائب وتجميد الأجور وتقليل الإنفاق على قطاع الخدمات الاجتماعية، كالصحة والتعليم والسكن والخدمات الأساسية، بحيث أصبحت غير قادرة على تلبية حاجات المواطنين، اضافة إلى مساهمة الأزمة في تآكل مدخرات المواطنين في الأسهم والمساكن.
واصبح هذا النهج هو السائد في الفترة التي تلت الأزمة المالية، فاتخذت الدول الرأسمالية الكبرى، العديد من الإجراءات السياسية والاقتصادية التي تحمي شركاتها في ظروف المنافسة الجديدة التي ظهرت بعد صعود الدور الاقتصادي للدول الرأسمالية الناهضة، كالصين والهند وروسيا والبرازيل، ولجأت إلى سياسة رفع الرسوم الجمركية على البضائع التي تنتج في هذه الدول، إضافة إلى حظر الاستيراد والعقوبات الاقتصادية على الدول التي ترفض هذه السياسة.
لقد تطور النهج السابق، خلال الأزمات التي واجهتها، الدول الرأسمالية الغربية مثلما حدث في التعامل مع الازمة الاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط 2022، إلى سياسة الحماية الاقتصادية التي تهدف إلى المحافظة على الأمن الاقتصادي الوطني للدولة، وبشكل يتعارض مع سياسة العولمة التي تتضمن انفتاح الحدود الوطنية لتجارة السلع والخدمات ورأسمال. بمعنى العودة إلى سياسة الحرب الباردة الاقتصادية التي أدت إلى أضرار بالغة في الاقتصاديات الوطنية والاقتصاد العالمي.
ومن أبرز ملامح هذه الفترة
- تراجع دور الحركة الماركسية والاشتراكية، وتأثيرها الفكري على الصعيد العالمي، بعد الصدمة التي تعرضت لها بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، حيث نلاحظ انحسار القاعدة الاجتماعية للأحزاب الشيوعية والعمالية في العالم وتحول الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية نحو اليمين في نهجها الاجتماعي والسياسي.
- ترافق مع جنوح الأحزاب الليبرالية "يمين الوسط" نحو اليمين، نمو التيارات الشعبوية ذات التوجه اليميني في كثرة من البلدان الرأسمالية وتوليها السلطة في الولايات المتحدة وبعض دول أمريكا اللاتينية البرازيل (سابقا) والأرجنتين، وفرنسا وبريطانيا والهند.
- تغيير استراتيجية الهيمنة الأمريكية من سياسة الاحتواء لعدو محتمل بواسطة العقوبات الاقتصادية والحرب الاستباقية المباشرة، التي طبقت في المرحلة الاولى، إلى سياسة الاحتواء بالواسطة، تأجيج الصراع الخليجي ـ الإيراني، التدخل العسكري الخليجي في اليمن، التدخل العسكري التركي في سوريا والعراق وليبيا، الحرب في أوكرانيا، الحرب الأرمنية ـ الأذربيجانية، الحروب الأهلية في عدد من الدول الأفريقية.
- تعزيز دور المخابرات الأمريكية، لتأسيس المنظمات المتطرفة، مواصلة تجربتها الواسعة بهذا المجال خلال الحرب الباردة(23) حيث ساعدت منظمات السلفية الجهادية (القاعدة وداعش واخواتها) وبالتعاون مع المخابرات التركية والخليجية، على تخريب الاحتجاجات الشعبية التي حدثت في عدد من الدول العربية، بلجوئها للعنف المسلح في صراعها مع السلطات الحاكمة، وكذلك دعم نشاط هذه المنظمات في عدد من البلدان الأفريقية، اضافة إلى دعم مجموعات المعارضة للتطرف في مواقفها في الدول التي ترفض الانصياع للمخططات الهيمنة الغربية.
- موقف متناقض من دور الدولة في الحياة الاقتصادية، ففي البلدان الضعيفة التطور حيث نلاحظ أن قوى الهيمنة الدولية تعمل على اضعاف هذا الدور، نظراً لأن الدولة هي القوة الوحيدة القادرة على تحريك مسار التنمية والتطور وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والوقوف بوجه مشاريع قوى الهيمنة الأجنبية لنهب ثرواتها، لذلك تطالب الدول الغربية التي تقود العولمة بتقليل دور الدولة الوطنية في الحياة الاقتصادية. في حين تجري زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية في الدول الرأسمالية الكبرى، خاصة خلال الازمات الاقتصادية، من خلال تقديم الدعم للشركات كتخفيف الضرائب وتقديم القروض، وحماية الشركات من منافسة الشركات الأجنبية، اضافة إلى الوقوف مع الشركات في نزاعها مع النقابات العمالية. لقد أدت ضغوط قوى الهيمنة الدولية بخصوص اضعاف دور الدولة الاجتماعي في العديد من البلدان إلى خلق حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، الذي وفر الشروط المواتية للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية(24).
- انتقال الحروب بين الدول إلى الحروب الداخلية بين القوميات والمذاهب والاديان، بحيث أصبح نهج التدخل غير المباشر في النزاعات الداخلية في الدول الوطنية هو السائد في سياسة قوى الهيمنة الدولية، خلال هذه المرحلة، خاصة بعد فشل سياسة الغزو العسكري لأفغانستان والعراق، نتيجة المقاومة الوطنية. أدى هذا التوجه إلى ظهور مفهوم "الحروب المنسية " وهي الحروب التي تترك بدون نهايات واضحة: الحرب الروسية -الأوكرانية، كنموذج، استمرار الحروب الأهلية، منها الحرب الأهلية في الصومال، السودان، اليمن، الكونغو الديمقراطية، العنف الهمجي للمنظمات الجهادية السلفية كداعش وتفرعاتها في دول الساحل الأفريقي، الحرب الإسرائيلية المستمرة على الدول العربية والشعب الفلسطيني.
لقد أدت سياسة التدخل السابقة إلى ثلاث نتائج، الاولى، شيوع حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في عدد كبير من الدول الوطنية، وتحول البعض منها إلى دولة فاشلة، تتحكم فيها العصابات المسلحة كما يحدث في هايتي، الصومال، افغانستان، العراق، لبنان، سوريا، على سبيل المثال، والثانية، ظهور المنظمات الدولية للسلفية الجهادية الإسلامية مثل القاعدة وداعش، المدعومة من الدول الغربية، والدول المحافظة في الخليج العربي وتركيا، التي امتد نشاطها إلى بلدان عديدة في آسيا وأفريقيا. والنتيجة، الثالثة، نهوض وطني ضد سياسة العولمة الرأسمالية، خاصة في الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية، أدى إلى وصول القوى الوطنية الرافضة للهيمنة الغربية، إلى السلطة في عدد من هذه الدول.
اما على الصعيد الاقتصادي، شهد تطور العولمة خلال هذه الفترة، ظهور ما يعرف بالكساد الاقتصادي المستمر ومن أبرز مظاهره:
- تكرار الازمات المالية خلال فترات قصيرة، التي يعبر عنها افلاس بنوك كبرى وتدخل مباشر من الدولة للحد من اتساع الظاهرة(25).
- تكرر أزمات العقارات في الدول الرأسمالية وخاصة الولايات المتحدة.
- الانهيارات المفاجئة للبورصة في الدول الرأسمالية الكبرى وتأثير ذلك على انخفاض الأسهم الذي ادى إلى تآكل مدخرات عدد كبير من المواطنين(26).
- عدم السيطرة على التضخم الذي يرتفع باستمرار وتأثير ذلك على ارتفاع الاسعار.
- تداخل الازمات المالية، مع أزمات أخرى، الازمة الصحية العالمية التي خلقتها جائحة كرونا، او مع ازمات اخرى ناتجة عن تحكم الولايات المتحدة بالنظام العالمي ذي القطبية الواحدة، كالأزمة التي خلقتها الحرب الروسية -الأوكرانية.
بعض الاستنتاجات
الأول، لا يعني إن مجريات العولمة الرأسمالية، تسير بشكل مستقيم وفق ما تخطط له الدول الرأسمالية الكبرى، حيث توجد كثرة من التناقضات بين هذه الدول، يفرزها قانون التطور المتفاوت، الذي ينتج عنه اشتداد المنافسة بين المراكز الرأسمالية الرئيسية، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا واليابان للسيطرة على الأسواق والمواد الخام في الدول النامية. وترافق مع هذه التناقضات نمو التيارات الشعبوية القومية المناهضة للسيطرة الأمريكية.
الثاني، العولمة الرأسمالية، افضت إلى ظهور اصطفافات جديدة، تحمل سمات، اقتصادية وسياسية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبني مواقف موحدة تجاه الازمات الدولية، والسعي إلى اعادة التوازن للعلاقات الدولية لخلق عالم أكثر عدالة قائم على تعدد الأقطاب، بدلا من الاحادية القطبية الأمريكية والهيمنة الغربية. لقد أصبح لهذه التكتلات مكانة مهمة ـ سياسية واقتصادية ـ على الصعيد الدولي، نظرا لقدراتها الاقتصادية والسياسية ومستوى النمو والتطور التكنولوجي العالي، ومن أبرز هذه التكتلات "منظمة شنغهاي" و"بريكس" اللتان تشكلان ما يقارب من ثلث الاقتصاد العالمي و 45% من سكان العالم وثلاثة أرباع الكرة الأرضية(27).
الثالث، نمو الحركة الشعبية، المناهضة لمخاطر العولمة الرأسمالية على الدول الوطنية، التي استطاعت إزاحة السلطات المتحالفة مع قوى الهيمنة الخارجية في العديد من دول أمريكا اللاتينية والدول الأفريقية.
الرابع، تعاني الولايات المتحدة من أزمة بنيوية تتمثل بعدم قدرة الاقتصاد الأمريكي على التفوق والمنافسة مع دول رائدة بالاقتصاد العالمي، خاصة الصين، التي تحتل المركز الثاني من حيث الناتج القومي، ومتفوقة بنسبة النمو والتكنولوجيا، وعجز الميزان التجاري الامريكي الذي بلغ في عام 2024 ( 1.2) ترليون دولار، وانخفاض نسبة النمو، مقارنة بدول عديدة، وارتفاع مستوى الدين العام (يبلغ بحدود 33 ترليون دولار) وبما يزيد على الدخل القومي السنوي. وأخير، يعتبر اللجوء إلى سياسة الحماية والعقوبات والرسوم الجمركية غير المنطقية على الدول الاخرى، دليلاً على ضعف الاقتصاد الامريكي وأزمته البنيوية.
الهوامش :
(1) ثقافة العولمة: القومية والعولمة والحداثة، مجموعة مؤلفين، إعداد: مايك فيذرستون، ترجمة عبد الوهاب علوب، المجلس الأعلى للثقافية، مصر، 2000، ص 29 .
(2) هذه الفكرة أوردها، توماس سنتش، نقلاً عن لينين ، نقد نظريات الاقتصاد العالمي، ت/ عبد الإله النعيمي، ج2، مركز الأبحاث والدراسات في العالم العربي، دمشق، 1990 ص 201.
(3) بيتر غران، "العولمة أو عدم النقاش حول الحداثة"، ت. فالح عبد الجبار، مجلة النهج، العدد 50 لسنة 1988 ص 74.
(4 ) سمير أمين، في مواجهة أزمة عصرنا، دار سينا للنشر، ط1، القاهرة 1997، ص 93.
(5) لطفي حاتم، العولمة الرأسمالية وإعادة بناء الياسر الاشتراكي، دار الحكمة، القاهرة، 2014، ص 160.
(6) جمال محمد باروت، "العولمة: تناقضات الواحد المنقسم"، مجلة النهج، العدد55 لعام 1999، ص 69.
(7)https://www.arabicacademy.gov.eg/ar/
(8) اسماعيل صبري عبدالله، الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الإمبريالية ، مجلة لكرمل العدد 53 تاريخ الإصدار 1 أكتوبر 1997. ص 86.
(9) الموسوعة العربية للمعلومات: https://ar-wiki.com/general/9355/
(10) تعريف لرئيس مجموعة رجال الأعمال، أورده: شونيه فرانسوا في كتابه عولمة رأس المال، مراجعة حسام عيتاني، جريدة السفير بتاريخ 1998-12-08 |
(11) يقسم رولند روبرتسن العولمة إلى خمس مراحل، الاولى الجنينية، والمرحلة الثانية، الولادة، والمرحلة الثالثة، الانطلاق، والمرحلة الرابعة، مرحلة الصراع على الهيمنة، والمرحلة الخامسة، مرحلة الشك. وبدأت من أوساط ستينيات القرن العشرين إلى بداية نهاية القرن الحادي والعشرين، واتسمت بالتأزم والصراع، ثقافة العولمة: القومية والعولمة والحداثة، مجموعة مؤلفين، إعداد: مايك فيذرستون، مصدر سابق، 26 ـ 27.
(12) يشير، سمير أمين، إلى ان العولمة أجبرت خلال هذه الفترة على تقديم تنازلات بسبب توازن ميزان القوى على الصعيد العالمي، مقابلة مع سمير أمين صدرت بكتاب، العولمة وبدائلها العولمة وبدائلها: مقابلة مع سمير أمين | Tricontinental: Institute for Social Research
(13) إن انهيار المعسكر الاشتراكي ترافق مع تدهور نسبي في أحوال الولايات المتحدة الاقتصادية وتوقع بعض المحليين إلى صعود قوى أخرى تنافس الهيمنة الامريكية على العالم في فترة ما بعد الحرب الباردة، أنظر المزيد عن هذه تحليلات، بيتر تابلور، كولن فلنت، الجغرافية السياسية لعالمنا المعاصر، ج1، ترجمة عبد السلام رضوان وإسحق عبيد، عالم العرفة، الكويت، 2002، ص 159 وما بعدها.
(14) انتقل تأثير أفكار الليبرالية الجديدة، إلى كثير من الباحثين والمفكرين والسياسيين، في الدول النامية ومنها الدول العربية، انظر، شاكر النابلسي، الليبراليون الجدد: جدل فكر، دار الجمل، بغداد 2005.
(15) للمزيد من تأثير سياسة الانفتاح الاقتصادي خلال هذه المرحلة من العولمة، أنظر: بيتر تابلور، كولن فلنت، الجغرافية السياسية لعالمنا المعاصر ج1، مصدر سابق ص 129.
(16) يعني مفهوم التدخل الإنساني، استخدام دولة ما للقوة العسكرية ضد دولة أخرى بهدف إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدولة المستهدفة. وقد بدأ تطبيق هذا المفهوم من قبل الدول الغربية في كوسوفو في عام 1990، حيث تدخلت قوات حلف الاطلسي في البلقان لدعم تفتيت يوغسلافيا إلى ست دول قومية.
(17) حسب إحصائيات ”فوربس FORBES ” " لعام 2007، https://worldpolicyhub.com/ar
(18) المزيد عن دور الشركات المتعددة الجنسية في ترسيخ العولمة الرأسمالية، يُنظر: أسماعيل صبري عبدالله، "الكوكبة أساس الظاهرة الاقتصادية والاجتماعية"، مجلة النهج، العدد 50، ص 23 ـ 25
(19) إن الوظيفة الأساسية للمؤسسات الدولية هي حماية الأسواق التي تسيطر عليها الاحتكارات وليس حماية حرية التجارة كما تروج لها سياستها المعلنة، للمزيد بشأن وظائف المؤسسات الاقتصادية الدولية، أنظر: سمير أمين، في مواجهة أزمة عصرنا، سينا للنشر، 1997، ص 97.
(20) بوستن فورسيك، رئيس منظمة آكسفام غير الحكومية، جريدة الزمان اللندنية، 30/9/2001.
(21) شهد العالم في عام 2023 أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ عام 1946، تم تسجيل 59 نزاعاً في العالم، ولم يسبق أن كان العنف في العالم مرتفعاً إلى هذا الحد منذ نهاية الحرب الباردة حسب تقرير معهد أوسلو لأبحاث السلام لعام 2023. كما يشير التقرير إلى أن ساحة النزاعات المسلحة أصبحت أكثر تعقيداً بسبب اشتراك عدد اكبر من الأطراف المتحاربة في نفس البلد. "عدد النزاعات المسلحة في العالم هو الأعلى منذ عام 1946 " جريدة الشرق الاوسط اللندنية 4 حزيران 2024. https://aawsat.com
(22) للمزيد عن مفهوم دولة الرفاه الاجتماعي، يُنظر: صالح ياسر، "العدالة الاجتماعية في دولة الرفاه.. بين السرديات والواقع الصارم"، مجلة الثقافة الجديدة، 452 أيار 2025.
(23) قامت المخابرات المركزية بدعم تأسيس المنظمات المسلحة اليمينية للعمل ضد الأنظمة الوطنية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، ولمحاربة الاتحاد السوفييتي في أفغانستان.
(24) تشير تجربة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلى الدور الهام الذي تلعبه سواء وقت الأزمات أو في التنمية، يُنظر: نعيم شومسكي وآخرون، العولمة الإرهاب، حرب أمريكا على العالم، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2003، ص108.
(25) للمزيد عن أسباب أزمة إفلاس البنوك، يُنظر: صالح ياسر الاقتصاد السياسي لأزمة بنك وادي السيليكون.. أزمة بنك أم أزمة نظام؟ الجذور .. الواقع.. الرهانات.. والدروس المستخلصة https://www.iraqicp.com/index.php/sections/orbits 26 آذار 2023.
(26) بلغت خسائر سوق الأوراق المالية خلال ثلاثة أسابيع من 15 تموز لغاية 7 آب 2024، 6.4 ترليون دولار. قناة العربية 7/8/ 2024.
(27) عزالدين عبد المولى، ديناميات الأحلاف والبحث عن توازن قوى عالمي جديد، التقرير الاستراتيجي لعام 2022ـ 2023 شبكة الجزيرة ص 37 ـ 46.