الشاعر الشهيد أحمد آدم في (دواخل *)

أنْ يستشهد شاعر في أول طريق الشعر يعني بالتأكيد أنه لم يصل لنهاية حلمه لا في الحياة ولا في الشعر. لكن أن يُكتب عن شاعر استشهد قبل أن يدرك أحلامه يعني أن ما كتبه قد وصل إلى القارئ. وعلى الرغم من أن الشاعر لن تتسنى له العودة مجدداً للحياة كي يقرأ ما سيُكتب في أثره إلا أن نصوصه الباقية ستتسنى لها فرصة حياة أخرى ما دامت لها القدرة على الانفتاح، وتمكين القراءة من النفاذ نسبياً على الأقل إلى مناطقها المطوية. هذا ما أحسست به عند الشاعر الشهيد أحمد آدم وما أراد قوله من خلال مجموعته الشعرية (دواخل) التي صدرت بعد استشهاده.
وعلى ذات المستوى من الإحساس تبقى قضية تأرجح الكتابة النقدية ما بين الإمكانية والاحتمالية، إذ مهما توسعت وتشعبت وتغلغلت في الطبقات الدفينة للنص عاجزة عن الإلمام بكل خفاياه والوقوف على كل سُننه، ذلك أن الصعوبة تكمن في التعامل مع مكوّن أميبي مراوغ عصيّ على الضبط والتحديد، وأن ما تُعلنه قشرته الخارجية أقلّ بكثير مما يُخفيه في طيّات طبقاته الداخلية، وأن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو ما يراه القارئ منها، أو ما يظن أنه يراه. وفي الحالين لا يمثل ذلك في النهاية حدود إمكانيات النص، ولكنه يمثل حدود إمكانيات القارئ التنقيبية التي تتباين مع حدود إمكانيات أي قارئ آخر على الرغم من أن الطرفين يستعينان بذات أدوات التنقيب. من هنا تأتي أرجحية الاحتمال على الإمكانية في القراءة، ومن هنا أيضاً تأتي القراءات والتأويلات التي لا حدود لها للنص الواحد، وتأتي معها مشروعيتها أيضاً على الرغم من تفاوتها واختلافها.
أما القارئ وهو في موقع الراصد فلا تهمه من الناحية الإبداعية الميتة الثانية الوجودية للشاعر، فهي قدره، لكنها بالتأكيد تهمه وتؤلمه إنسانياً إلى حد الانسحاق، ولكن هذا ليس مجالها فليس القارئ هنا في موقع التأبين، بل هو في موقع القراءة، ولذلك فإن ما يهمه هو تتبع انزياحات الميتة الأولى النظرية (موت المؤلف) التي ستورث النص للقارئ بعد أن ترك له صاحب النص حق التبني، يعني أن يُقرأ النص ليس بحسب ما تمليه عليه هندسة الباني، بل بحسب ما تتمخض عنه احتمالات التقويض.
ربما لم يخطر في بال الشاعر الشهيد أحمد آدم أن مجموعته الشعرية (دواخل) ستكون المثال التطبيقي الحقيقي غير المجازي لمقولة (موت المؤلف) وهي ستكون في الوقت ذاته خاتمة حياته الإبداعية والوجودية معاً، والميتتان تقدمان للقارئ فرصة القراءة الحرّة من دون تدخل خارجي مقوّم أو معترض أو مُفسّر. ومفهوم القراءة الحرّة هنا هو انعكاس لفكرة عزل المؤلف عن نصه باعتبار أن المُتبنّي/ القارئ في الميتتين سيكون الوريث الشرعي، وسيّد ما يقرأ.
لكنّ لقاء القدر مع القراءة في إنتاج ميتتين افتراضية ووجودية خلّف للموت أثراً في نصوص الشاعر، وقد تجلى هذا الأثر بأكثر من صيغة، ولكننا هنا آثرنا الوقوف على اثنتين منها، الأولى وهي الصيغة النمطية المفارقة للحياة. والثانية هي الصيغة الرمزية متمثلاً بموت الأمل، أو الحلم جراء فشل التجربة ومفارقة النجاح. وهذا الثاني هو ما ستبدأ بفرزه وإضاءته هذه القراءة من خلال تجربة الآخر في قصيدة (قمم سفلى)، ولعل أول ما يلفت النظر في هذه القصيدة هو المفارقة في العنونة، حيث تشير مفردتاها إلى محطتين متضادتين؛ المفردة الأولى تشير إلى الحلم في أعلى مراحل تحققه. والمفردة الثانية تشير إلى إخفاقه وتهاويه. والشاعر يتحرى كلتا المحطتين من خلال تجربة (الطامح بالفوز)، وهو توصيف لشخصية هلامية غمرها الشاعر بطبقة كثيفة من التمويهات، وزادها ضمير الغائب غموضاً، إنه يرنو إلى القمّة التي لم يكن قد أعدّ لها عدتها، بل لم يكن ليؤمن بمشروعية تلك العدّة، فهو صاحب حلم، لكنه (حلم من دون قاعدة)، إذ لم تكن طموحاته الواسعة لتتوافق مع أهدافه الضيّقة. وبذلك فالقمة التي بناها ستتهاوى (مثل حجر صغير)، وكما ابتدأت القصيدة متوافقة مع المفردة الأولى من العنونة توافقاً نسبياً على الأقل سواءً في بنائه (بنى قمّة)، أو في عزفه (كان يعزف)، انتهت متوافقة مع المفردة الثانية منها، ليشهد ذلك (الطامح بالفوز) الموت الروحي في أقسى صوره، أنه موت الحلم:
بنى قمّة
كان يعزف
ولأن حلمه بلا قاعدة تهاوى
مثل حجر صغير
وبشيء من الوضوح ممزوجاً بشيء من التلميح يتناول الشاعر سبب ذلك التقاطع والتصادم ما بين الطموح العريض من جهة، وما بين نظرته الضيقة إلى أهدافه من جهة أخرى، والذي سيؤدي في النهاية إلى تبديد الحلم تبديداً يتبدّى استعارياً على هيئة سيّالة كنهر طافح (لكنه بلا ساحل):
الطامح بالفوز
طافح بالكراهية
لا يُحلّق بنجمة
يدخل الأمل قلبه
من شدّة الخوف
لكنه ...
طافح بلا ساحل
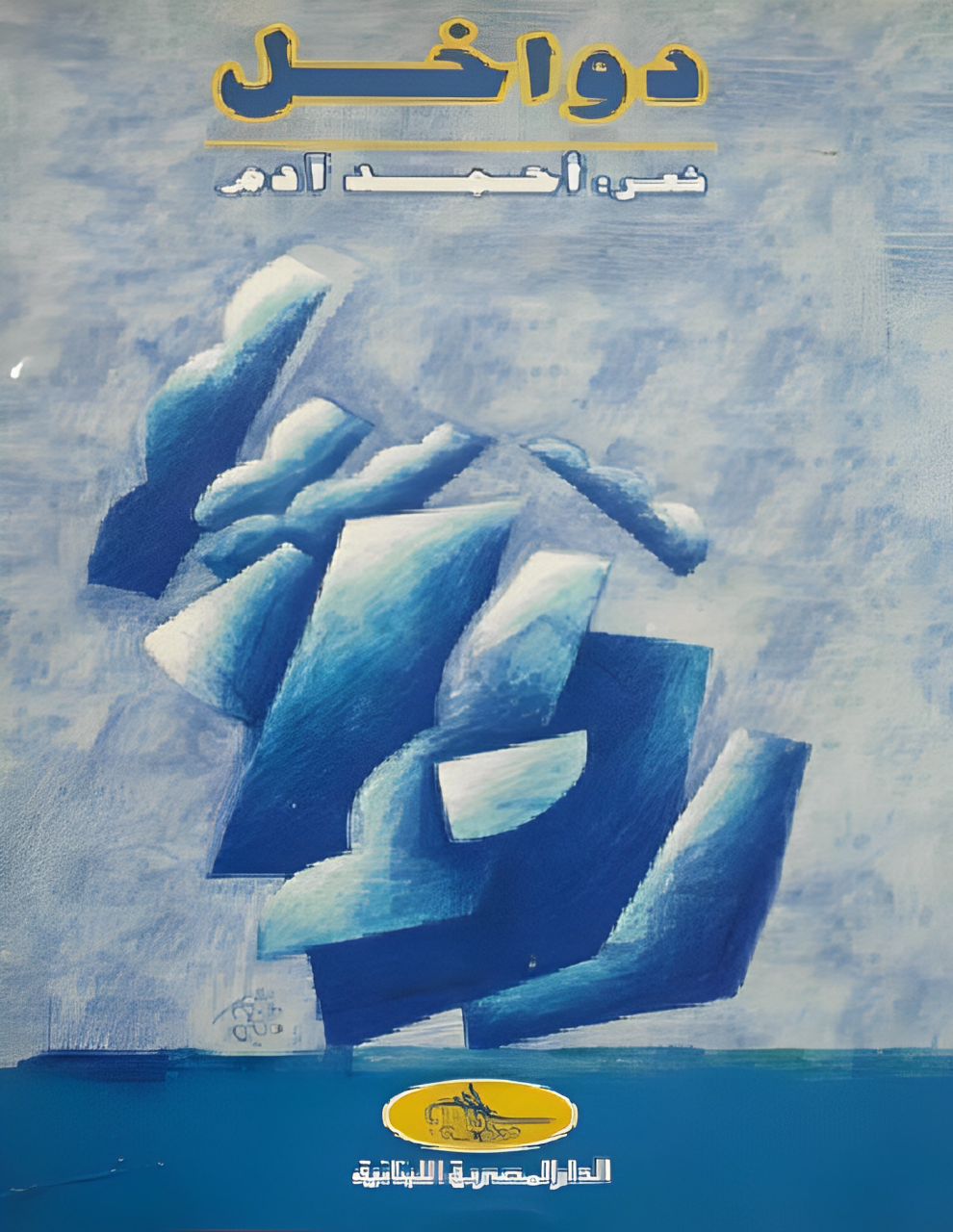
ومن الواضح أنّ عبارة (الطامح بالفوز) تنطوي على إدانة خفية، فهي تضمر في مفردتيها إيحاءً بالاستحواذ غير المقبول على ما هو ليس من حق الطامح، وبذلك فالشاعر عبر ما يُشبه التلويح بالإدانة يُميّز نفسه عنه، لأن قداسة الشعر لا تسمح له بالاستحواذ على ما هو ليس له. إذن فالفوز ليس فوز الشاعر، وكذلك الحُلم ليس حلمه، وبالتالي فـ (الأمل الطافح بلا ساحل) ليس أمله. أما آماله وأحلامه هو فلم تتحقق بعد، وأن تحققها مرهون بعودته حياً كما يقول لأصدقائه في قصيدته (عندما أعود حيّاً) من دون أن يحدد بوضوح لا لبس فيه عودته من أين؟ لكنه يُلمّح أنها ستتم (حين أكون ناضجاً في الرحيل)، ومن دون أن يوضح لماذا قيّد بُعدَه باحتمال الموت، لكننا سرعان ما نؤوّل ذلك ونحن نقرأ جداول وعوده وأحلامه الكثيرة. أما أحلامه لمرحلة ما بعد العودة فهي ليست مرهونة بعودته حياً فحسب، بل بتغيّر الظروف التي كانت تمنعه من حرية الكلام، والتي كانت قد أوقفت حركة الزمن، من أجل أن يبني، بل ومن أجل أن يحقق أحلامه التي يمكن رصدها عبرَ:
- أفتح أبواب كلمتي المخبّأة على وسعها
- أغيّر الروزنامة بكل آثامها
- أعمّر مدناً تُسوّرها ذاكرتي حنيناً
- أنتشل ينابيعاً تواصل نحيبها
- أضع وروداً للمارين كجنود مجهولين
راسماً حلماً يسعى صوب معناي
- أعاند لساناً أعرج شتم روحي
وبعد سيل متدفق من أحلام العودة يتجلى الحلم المفتاح، أو الذي يتراءى لنا أنه كذلك، والذي به ربما تنفتح مغاليق القصيدة، حيث يتبين سبب البعاد، وسبب احتمالية ارتباطه بالموت، وسبب الاحتفالية الجمعية بالعودة حياً (سنحتفل معاً). إنها العودة من الحرب أو من الحروب. فكيف ستكون ذروة احتفالات الشاعر بالعودة حياً من الحروب:
أحاول نسيان ... وجه الحروب
أيدي الحروب
اغماضة الحروب
جثّة الحروب
ولكن العودة التي يُفترض أن تكون سعيدة من الحروب هي لا تقلّ تعاسة وبؤساً من الذهاب إليها، إنها العودة التي لا تُخفي وجه الكوارث المميتة، بل تكشفه على حقيقته الصادمة:
عندما أعود حياً
تستقبلني الثكلات
حتى أعيد الرجال إليهنّ بلا همهمات
وإن كانت القمم الوهمية (السفلى) قد اقتادت إلى هاويتها من لم يُعدّ عدة كافية للصعود، إلا أنه لم يهوِ إليها بمفرده، بل سيجرف معه الآخرين، ومنهم الشاعر الذي تتراءى له الهاوية المعتمة، بالرغم من أن افتتاحية المجموعة تنبئ بشيء من الإضاءة (إلى الداخل المضيء أبداً وهو يمضي لروعته) إلا أنها ليست سوى ومضة خافتة سرعان ما تُطفئها القصيدة التي تعقبها مباشرة، بل أن الشاعر شاء لتلك الافتتاحية أن تُكتب متقطّعة ومتدرّجة على شكل سُلّم متّجه نحو الأسفل:
إلى
الداخل
المضيء
أبداً
وهو يمضي
لروعته
فكأنه أراد بهذه الومضة الخافتة أن يُعدّ القارئ لتقبّل حالة انطفاء مفاجئ، وهذا سرعان ما حققته القصيدة الأولى في المجموعة (رأيتُ أيضاً) المهداة (إلى الذي رأى كلّ شيء/ كلكامش)، بيد أن هناك ثمة تقاطعاً ما بين رؤية كلكامش الذي رأى رؤية المستيقظ بعينيه أو رؤية الواعي بعقله، وما بين رؤيا الشاعر، وهي رؤيا الحالم، بدلالة الفعل الافتتاحي (فسّر) الذي يبدأ به السطر الأول من القصيدة بعبارة (فسّر لي) والذي يُستخدم محلياً في العراق لتعبير الرؤيا.
والأحلام التي يطلب الشاعر تعبيرها من ضمير الغائب (وهو الضمير المهيمن على قصائد المجموعة) هي ليست أحلاماً بل كوابيسٌ:
- الأرحام: عزفت نحيباً
- الطين: منثور على أيامنا
- الساحات: ضحكات ملائكة متآكلة
- المدينة: سالت
- الغيوم: ارتدت رمادها
- الخرائط: أسيجة
- كل دخول: موت
- كل خروج: منفى
- الحدود: أفاع حمر
- الأيام: تُلقي عليّ ستائر شيبها
- الشمس: تنشر الوقت الذي ينسحق
وبعض تلك الأحلام/ الكوابيس تفارق يقينيتها الفلسفية من خلال مبارحة الصيغة الخبرية القابلة للحصر ما بين حدّي التصديق والتكذيب، ومن ثم التشكّل في صيغة إنشائية من خلال صيغ الاستفهام أو الأمر أو النهي:
- هل نعود من نفق الكون؟
- من يدفع عجلات العيون
أن تشاهد؟
- من أتوجه إليه كاشفاً؟
- أمسكْ لو أردت
قلب حجر
- لا تُفاجئني اللحظة
قلبك أجعله لا يدق مؤقتاً
حتى يجيء في وهج نواحك
أو من خلال صيغة إنشائية مزدوجة تجمع ما بين النهي والتساؤل:
- لا تقلْ ...
ذلك ليل كيف أشطبه؟
وهكذا لا يظل شيء من الكليات أو الجزئيات الكونية في موقع استقراره واطمئنانه، ما دام المنطق قد أسلم قياده لكوابيس الانهيار. ومع ذلك فالقصيدة الطويلة نسبياً تستدرك في سطورها الأخيرة هذا الخلل المنطقي الذي يُمهّد لانهيارات وجودية في حال تحققه واقعاً معوّلة على ضمير الغائب إصلاح ما أفسدته، ولتُعيد لذلك الضمير تألقه الضائع من دون أن يغادر ذلك الغائب حدود كوابيسه بدليل أن ازدياد شدوه كان تحت تأثير النعاس، فكأنّ الشاعر كان يأمل أن يضيء تألق ذلك الغائب بمفرده عتمة الكوابيس الكونية. ولكن ذلك الأمل لم يكن سوى وهم، لأن تألق ضمير الغائب لم يُفارقه الانكسار:
ازداد في شدوه نعاساً
ازداد نوراً
في تكسّره
وعلى إيقاع الانهيار ذاته تأتي قصيدة (بانوراما الدم) مستبقة دهشة القارئ بعنوانها الصادم فكأنها لا ترى إلى أفق الوطن فحسب مصبوغاً بالدم، بل إلى أفق العالم أجمعه ما دام الشاعر لا يتوانى أن يصدم توقعات القارئ بإلقاء وزر هذا الدم أولاً على عناصر الطبيعة التي أخرجها من حياديتها ووضعها في موضع الاتهام:
فالأفق = وحشٌ
والرمل = يمرق في جرحي فأكتبه
والسماء = فاتها وقت المطر
والأرض = التهبت
والسماوات = أحالت كلّ شيء إلى ظلمة
والفصول = أجزائي انكسرت / تجرفها قيامة الفصول
أما الإنسان/القاتل الحقيقي فلم يحضر في تلك البانوراما الدموية بذاته، بل بواحدة من أسوأ مواصفاته ألا وهي (الأنانية) من دون أن يربطها الشاعر ربطاً صريحاً به، ولكن القارئ هو بالتأكيد سيتكفل بهذا الربط، فليس من المنطقي أن ننسب الأنانية أيضاً إلى الطبيعة، بعد أن نسب إليها الشاعر ما هي بريئة منه، ومع تفعيل هذه الخصلة الإنسانية المجرّدة، وقبل إدراج القرينة النصّية التي تؤكدها، من الضروري التذكير بإن إحدى مواصفات قصيدة أحمد آدم هي التعلق بالمجرّدات، والاستعاضة بها عن الملموسات، مع نسب خصائص ووظائف الثانية إلى الأولى :
ألأنانية أتلفت روعة الأفق
هبطت ناثرة يباسها خيانة
وقبوراً
وبعد هذه الاتهامات للقتلة الأبرياء/عناصر الطبيعة، وبعد التمويه للقاتل بمواصفة مجرّدة واحدة من مواصفاته، يحضر القاتل فجأة من خلال عين الشاعر التي رأته، ورصدت تنقلاته. لكن حضوره هو ككل حضور للآخر في أغلب القصائد عبر (ضمير الغائب)، بدون هوية، وبدون ملامح، بل وبدون إدانة، فتلك ليست مهمة الشاعر القديس، لأن توجيه الإدانات ربما قد يُدنّس قداسة الشعر. كل المتاح ضمن فسحة البوح هو رصد حركة القاتل وتنقلاته، ونقلها للقارئ على شكل خارطة شعرية تبدأ بالقوافل ثمّ القباب ثمّ الأبواب، مع تحديد الفعل الذي يؤديه في كلّ محطة، وعلى القارئ أن يستحضر قدرته لتأويل تلك الأفعال وكشف أسرار بعض تلك المحطات لتحديد هوية القاتل الذي (بصمت دامس يلقن القباب):
ورأيته
يُسيّر القوافل
بصمت دامي يُلقن القباب
يفتح الأبواب عن رعدة الخوف
يبعثر السقوط
ورأيت شرّاً شديداً تحت الشمس يتبعه
وأخيراً يستفيق الشاعر من كابوس الحقيقة ليجد نفسه بين أكوام من الجثث وهي تستفزّ حيرته:
أفقتُ والجثث استحضرت أسئلتي
غطّت مساحة حيرتي
أو:
انتشرت الجثث هابطة وصاعدة
وارتمت في لحظة
استعادة الجرح ذاكرة الظمأ
ومن اللافت أن إفاقة الشاعر ما بين الجثث ليست إفاقة من النوم، بل هي إفاقة من النسيان، إنها فرصة لاستعادة الذاكرة المدفونة تحت ركام الكوارث والأزمات، واستحضار آلام وجراحات الماضي متمثلة بمعاناة الحصار الذي أوشك الشاعر نسيان كوارثه لولا أن بانوراما الدم قد أعاده إلى ذاكرته (تقافزت في ذاكرتي اشتباكات الحصار).
أما إذا ما تلاشت الأحلام/ الكوابيس، وتوارت نبوءات الإخفاق والموت، فالأسى والضياع حاضران:
ذات اليمين
عرائس وحروف وطرق
تُخلّد صدره بالأسى
وهو باسط نظره ملياً
فلا يجد غير رصيف
يطلّ على الصحراء
وحتى في قصائده الغزلية التي يحاول فيها جاهداً التطلع لأفق أكثر إشراقاً وانفتاحاً يمارس فيه غريزة الإنسان السوي في الحب، فأن هاجس الفراق أو القطيعة سواء بالموت أو بسواه لا يفارقه أبداً، وإن كان هو نفسه لا يبوح به فستبوح به حبيبته، ولا فرق في من يبوح، فهي إحدى ألاعيب الشعراء أن يجعلوا حبيباتهم ينطقن بما في نفوسهم. ولنستمع للحبيبة تبوح له بما في صدره هو من الهواجس التي هي هواجسها أيضاً:
الكلّ عادوا
من أمام الضياع
من هروب الحقيقة
من أرض وراء النار
من مقابر لا تشبههم
من وراء القضبان
من ... من
لا أهتم كيف
إلا أنت يا حبيبي
هل أنتظر؟
هل؟
أحمد آدم: ولد في قضاء الهندية، محافظة كربلاء عام 1967، حاصل على البكالوريوس من كلية التربية من جامعة كربلاء، متزوج وله ولدان وخمس بنات، مارس العمل الصحفي ونشر مقالاته وتقاريره في جريدة (المدى) التي كان مراسلها في كربلاء. صدر له المجاميع الآتية: (تكوينات نصوص) 1997، استدراك 1999، كون في داخلي 2000، دواخل 2005 (صدرت بعد استشهاده). قتل ذبحاً، هو وزميله الصحفي نجم عبد خضر، في منطقة اليوسفية، من قبل عصابات الإرهاب الظلامية خلال عودتهما من بغداد إلى كربلاء في 15 مايس 2005.
(*) دواخل – شعر أحمد آدم – الناشران ديوان المسار والدار المصرية اللبنانية – الطبعة الأولى – 2006