الرهان على وحدة اليسار وهزيمة الرأسمالية
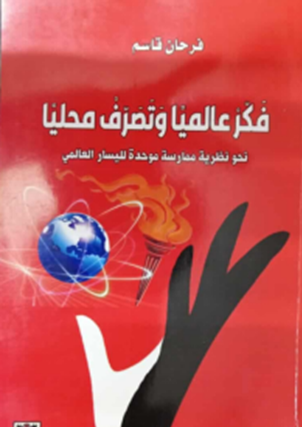
- الاستهلال:
خير ما أبتدئ قراءتي لكتاب الكاتب والباحث فرحان قاسم الذي استعار له عتبة عنوان (فكّر عالميًا، وتصرف محليًا) العتبة التي كما يراها مقولة متداولة في أوساط اليسار العالمي ،وذات دلالات عميقة في العلاقات بين ما هو خاص وعام، هو أن أبتدئ بباب الكتاب ومبتدئه، وأعني متن الغلاف وعتبته العنوانية التي هي أولى العلامات الدلالية لمتن النص العام للمُؤَلف، والممر إليه، وأجده أخذ مساحة الثلث الأعلى منه، ليتوسط أعلاه اسم المؤلف، وفي زاوية أسفله اليسرى أيقونة الدار الناشرة، ومن الأسفل تنبثق كفُّ يسرى تقاسمها اللونان الأسود والأبيض في اشارة الى المكون البشري، وثنائية الوجود، فيما تتوسط الكف (اليسارية) الشعلة، تأريخيًا لتعبر عن دلالات كثيرة وعميقة، نحو وتوجه الحياة والأمل ضد الموت وفقدان بوصلة الطريق، والنصر ضد الهزيمة، والمعرفة ضد الجهالة، والحكمة ضد التهور، والمساواة ضد الاستغلال، والكشف عن الحقيقة مقابل كل غامض ومستور مجهول، فيما تعبر أيقونة الأرض إذا ما تجاوزنا دلالتها المكانية المباشرة، إنما تعبر عن كيانٍ وجوديٍّ للإنسان، وإلى هويته الكينونية التي تتجلى في مركزية حياته وكل محيطاته الذاتية والموضوعية، بيئة وتفاعلًا مجتمعيًا، وتعايشًا إقليميًا وعالميًا، وصراعاتٍ سياسية من أجل البقاء على سطح هذا المسكن الكبير من دون استغلال إنسان لابن جلدته الانسان، أو استغلال دولة/ دول لشعوب دول أخرى، وهذا ما تجلّى في الأيقونة البصرية التصويرية إلى جانب يسار الغلاف. أما دلالة اللون الأحمر الذي غطى مساحة متن الغلاف، فهي تعبر عن دلالة اليسار التقدمي العالمي بكل تياراته الفكرية، والأيديولوجية العقائدية، فيما دلالة اللون الأبيض تعبر عن السلام العالمي الذي ينشده نزلاء هذا المسكن/ الأرض الذي وفرته الطبيعة لهؤلاء النزلاء من البشر. الأرض هنا هي المرآة لهوية الانسان الكونية التي عبرت عنها فنون الأدب السردية والشعرية، وفنون الرسم والتصوير البصرية.
ولو تأملنا دلالة عتبة عنوان متن الغلاف المركزية (فكّر عالميًا، وتصرف محليًا)، سنجدها دلالة مركبة، تبعًا للسانية العنوان الفعلية المركبة هي الأخرى، مع تحملها سياقات مختلفة، وبخاصة في سياق التفكير السياسي، فإذا كان لأفكار شخصية سياسية على سبيل الاستشهاد والايضاح، معنى مؤثر وفاعل، وقيمة مفيدة نافعة سيتوجب عليه أن يذهب بتفكيره باتجاه عالمي، ثم ليعمل أو يتصرف في المركزية المحلية، ولكن عليه أن يدرك فيما بعد أن ذلك المعنى، وتلك القيمة اذا لم يكونا مرحبا بهما هناك، وغير صالحين، عليه أن يقرّ بعدم صالحيتهما هنا في مركزية وأطراف محليته. بمختصر الفهم والتأويل فإن عتبة العنوان المركزي التي إختارها الكاتب والباحث فرحان قاسم بقصدية مدروسة، وانتقاء محسوب، وذلك لإيحائيتها ورمزيتها المعبرتين عن فكرة/ أفكار سياسية، واقتصادية ومجتمعية إنسانية وبسياقات مختلفة تتماس مع بعضها بعضًا حينًا، وتتوازى، أو تتقاطع مع بعضها حينًا آخر، أما عتبات العناوين الداخلية لمتن النص الداخلي التي ضمتها الفصول السبعة، فإنها قطعًا تتعالق من حيث المفاهيم والدلالات فيما بينها، وفيما بينها وبين عتبة العنوان المركزية التي ضمها متن الغلاف العام.
وأرى أن صدور، وأهمية الكتاب البالغة تأتي في الراهن المعيش كون البلاد ودول الإقليم تعيش مرحلة تحولات غاية في الخطورة في ظل صراعات جيوسياسية، وعسكرية معقدة والنتائج الكارثية، فضلًا عما يحصل من صراعات اقتصادية مصالحية، واحترابات تدميرية على الصعيد العالمي.
فعلى الصعيد المحلي والإقليمي شهدت حركات اليسار خلال العقود المنصرمة معاداة ومناهضات من قبل قوى قومية عنصرية يمنية غاشمة، إلى جانب حلفائها من التيارات الإسلامية المتشددة بهدف تقويض تلك الحركات مهما كلفها الأمر، ومهما دعاها ذلك الى مسوغات حتى جثت على صدور شعوبنا أنظمة ديكتاتورية باطشة، وثيوقراطية مستبدة متخلفة. لكنَّ المؤلف من بين ما يرى ويستقرئ، وكما يرى يساريو العالم أن يسارًا جديدًا ومعاصرًا قد أعاد حساباته، وقواه وأفكاره البنيوية والثورية اليسارية ذات الأهداف الإنسانية الصرفة، بهدف استمرارية الصراع حتى هزيمة الإمبريالية العالمية، ونظامها الرأسمالي الجشع الذي يعد نفسه وصيًا على حياة الشعوب، لكنّ رهان الهزيمة المدوي، سيشهده العالم بسبب ما يجري من حروب وأحداث وتداعيات خطرة...
2-قراءة المتن:
تتعالق عناوين الكتاب بدءا بعنوانه وكل مؤثثاته الدلالية، وهذا التعالق بحد ذاته ووظيفته إنما لصالح محمول الكتاب الرئيس العضوي ألا وهو الصراع التأريخي بين تيارات اليمين واليسار، الرأسمالية والاشتراكية ليس على الصعيد المحلي والاقليمي فحسب، بل على صعيد صراع متوحش، أذاق قسرًا الكثير من حياة البشر طعم الرماد، رماد الحروب والتدمير والخراب والموت على مدى قرون خلت، لم تنفك أحداثها بما لحقها من كوارث وأحداث، متصلة بما هو معيش وراهن، صراع ارتكب موتًا عدوانيًا على أمم وشعوب ومازال...
ويمهد الكاتب للمتلقي بمقدمة مضيئة؛ محمولات الفصول ومحيلة إليها بهدف التأويل والفهم والتفسير والإجابات عن الصراع الجدلي وتداعيات أهدافه ونتائجه على تشكيلات الأسرة البشرية في بيوتات حياتها التي تتوزعها جغرافيا العالم.
في المقدمة يتساءل المؤلف ويسأل في الوقت نفسه عن قضايا إنسانية مصيرية ضاغطة ومؤثرة تتمحور في بؤرة إنسانية محضة، كما في سؤاله عن الموقف من صورة "الإنسان ذي البعد الواحد" في البلدان الرأسمالية، الصورة كما فهمها هربرت ماركوزه وطرحها. ويتساءل أيضًا: " لماذا أصبحت الثورة ممكنة وحتمية في البلدان المتخلفة، وكيف لم تتحقق في عالم يمتلك تلك القوة؟" ما دور اليسار هنا وهل تمكن من وضع مفهوماته في أطر سليمة وواضحة بهدف تكوين نظريته الخاصة في الممارسة السياسية المحللة للظواهر الحياتية على الصعيد النظري؟ ثم تطرح المقدمة تساؤلها ثالثًا مهمًا ومحوريًا وهو هل أن استغراق اليسار في الخاص والمحلي أعاق تحقيق مهمة توحيد اليسار على مستوى ما هو عام ومشترك؟
يرى قاسم ان "ماركس هو أول من أدخل مفهوم الممارسة في نظرية المعرفة" ليصبح النشاط النظري مترابطًا مع الممارسة والنشاط المباشر الذي يمارسه الإنسان على بيئته. ومن خلال ذلك التفاعل بين النظرية والتطبيق، ثم ليؤكد أنه اعتمد منطلقه لدراسة اليسار كظاهرة لها تأريخها الخاص، على هذا النهج، متتبعًا أساليب الحركة اليسارية منذ تأسيسها في كفاحها ضد النظام الرأسمالي العالمي، وظهور الحركات العمالية في إنكلترا مع تفجير الثورة الصناعية مطلع القرن التاسع عشر.
3-النظرية السياسية:
يقدم المؤلف مفهوم النظرية السياسية المختلف عليه، على بقية محاور مفاهيم فصول الكتاب الستة الأخرى، يقدمه بوصفه محيط وأس الأنظمة السياسية التي "تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل المجتمعات البشرية، والقوة الدافعة وراء تشكيل الحكومات، ووضع القوانين، وتوزيع السلطات".
ويشير المؤلف إلى عدم اتفاق الباحثين في حقل السياسة ومجالاتها على تعريف واحد يوحد رؤيتهم لـ(النظرية السياسية ) التي هي:" مجموعة من الأفكار والمفاهيم التي تهدف الى تفسير وتحليل الأنظمة السياسية، وتوزيع السلطات والعلاقات بين الأفراد والدولة وأسس الحكم. تتضمن النظرية السياسية دراسة قضايا مثل العدالة، الحقوق، السلطة، المساواة، وكذلك فهم تأثر الهياكل السياسية على المجتمع وكيفية اتخاذ القرارات في اطار سياسي معين"، ثم يأتي الباحث على بعض المختلفات في تحديد المفهوم والرؤية حول النظرية السياسية، فهي عند بعض الباحثين: "دراسة المفاهيم والمبادئ التي يستخدمها الناس لوصف وتفسير وتقييم الأحداث والمؤسسات السياسية"، لكنّها عند باحثين آخرين :"اطار فكري يفسر مجموعة من الحقائق العلمية، ويضعها في نسق علمي مترابط، وانها تفسر ظاهرة معينة بنسق استنباطي"، أو أنها: "مجموعة من القضايا التي ترتبط معَا بطريقة علمية منظمة، والتي تعمل على تحديد العلاقات السببية بين المتغيرات"... الخ. ومع أن الباحث يعتبر تعريف صاحب كتاب "اليسار الجديد" موريس كرانستون جامعًا مانعًا لمفهوم السياسة: "السياسة كنشاط هدفه المحافظة على مجموعة من القوانين وتنفيذها بحيث تؤمن المجتمع ضد الفوضى والانحلال كي تستمر الحياة العادية"، فإنه يخلص من بين مختلفات التحديد والتعريف إلى معتمده ومستنتجه التعريفي الخاص الذي ملخصه: "النظرية السياسية هي مجموع النظريات والآراء والتكتيكات والأساليب والآليات التي تستخدمها الطبقات المهيمنة على السلطة لتأبيد سيطرتها على المجتمع بكافة طبقاته وفئاته وشرائحه"، ثم ليؤكد أن منطلق تعريفه هذا هو من حقيقة أن الأحزاب السياسية وتياراته المتصارعة إنما تهدف في نهاية المآل والصراع والخصام والمطاف إلى النيل والإمساك بدفتها وسنام كرسيها .
4 ـ أس الصراع:
ومن نشأة ومفهوم اليسار، وطبيعة الصراع التأريخي التناحري بينه وبين رأس المال، والقضاء على ظاهرة الاستغلال الذي يعده الهدف الرئيس للفلسفة الماركسية، وفكرها الاشتراكي .. ان الماركسية التي عدت الملكية الخاصة هي أس وجوهر الاستغلال، وهي لم تكتفِ بهذا الاعتبار والتحديد والتشخيص، بل طرحت الحل المركزي والبديل الجوهري وذلك بجعل ملكية وسائل الانتاج ملكية عامة.
وشملت تلك التنقيبات الفكرية الدقيقة ما يواجه اليسار على مختلف جغرافياته المحلية والاقليمية والعالمية تحديات معاصرة جمّة وكبيرة ما يجعلها تؤثر على أنشطته وحضوره، وفاعليته وتأثيره في السياسة والمجتمع، وأيضًا البحث في مفهوم اليسار والغموض الذي صاحب نشأته، ثم لينختم متن الكتاب. وفي فصله الأخير "نحو نظرية في الممارسة لليسار العالمي" يرى الباحث أننا دائمًا ما نكون بمواجهة سؤال مفاده: لماذا نفكر بنظرية في الممارسة يجتمع عليها اليسار في كل العالم؟
وفي "ممارسة اليسار" نتبين ظهور مفهوم اليسار إلى الثورة الفرنسية 1789 وحصرًا وتحديدًا تحت قبة برلمانها، ليعبر عن هموم وتطلعات الطبقات والفئات الاجتماعية التي تناهض النظام الإقطاعي الجائر، ثم ليشير ومنذ العام 1848 إلى امتداد حركة اليسار الأفقي ليشمل قارات العالم كافة، وامتداده عموديًا أيضًا، وذلك لتنوع رؤاه وتعدد تحليلاته في عموم طبيعة الصراعات وتداعياتها على الصعيد الإنساني في مختلف شؤون الحياة.
ويرى الباحث: "أن الفكر اليساري انجب عددًا كبيرًا من المفكرين ؛ عجزت عنه أية حركة فكرية او سياسية أخرى على مدى تأريخ البشرية، سواء كان منهم أصحاب فكر مثل ماركيوز، غرامشي، بليخانوف، وسمير أمين، أم رواد نضال وعمل يومي مثل تشي جيفارا، وشفيع الشيخ، ونزيهة الدليمي، أم شخصيات جمعت بين التنظير والممارسة اليومية للنضال المباشر كماركس وانجلز، لينين، روزا لوكسمبورغ، ومهدي عامل، فانهم جميعًا يستندون إلى مبدأ وحدة النظرية والتطبيق"، عادًّا الماركسية :"هي أدخلت الممارسة كمعيار للحقيقة في صلب نظرية المعرفة"، فالناس كما يقول ماركس ((يصنعون تأريخهم الخاص، لكنهم لا يصنعونه باختيارهم الحر وليس تحت ظروف اختاروها بانفسهم بل تحت الظروف التقليدية المباشرة والموجودة القائمة)).
ويبرز الباحث أهم التحديات المعاصرة التي يواجهها اليسار اليوم، والتي تؤثر على أنشطته وفعالياته وقدراته المثرة في العمل السياسي والمجتمعي، ولعل من أبرزها كما يحصرها الفصل الخامس " التحديات المعاصرة التي تواجه اليسار": معارك المفاهيم، العولمة الاقتصادية، العمالة الرخيصة، التهديد للسيادة الوطنية، التهديد للبيئة، تآكل الثقافة المحلية.
ويناقش الباحث مفهوم اليسار، وهو المصطلح نفسه الذي تصدر عتبة عنوان الفصل السادس من الكتاب، وما اكتنفه من غموض مع بدايات نشأته وظهوره، ويعود استعماله بحسب "بيكلز" في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية الى تأريخ ـ على المستوى السياسي ـ في الخامس، ثم الثالث والعشرين من يونيو 1789 في فرنسا التي ترجع بعض المصادر والمرجعيات أصل مفهوم اليسار إلى ثورتها وتحديدًا عندما شهد البرلمان الفرنسي جلوس النواب الليبراليين الممثلين لطبقة العامة أو الشعب على يسار الملك لويس السادس عشر في اجتماع لممثلي الطبقات الثلاث للشعب الفرنسي عام 1789، فيما جلس النواب الممثلون لطبقة النبلاء ورجال الدين على يمين الملك في ذلك الاجتماع المهم الذي أدى إلى سلسلة من الإضرابات والمطالبات من قبل عامة الشعب وانتهى إلى قيام الثورة الفرنسية، ومازال هذا التقليد جاريًا في البرلمان الفرنسي إلى اليوم.
ويرى الباحث أن تحديد مفهوم اليسار سيساعدنا على تحديد الأحزاب والتيارات والشخصيات وتحديد الحلفاء والخصوم، وايضًا يساعدنا على تحديد الأهداف ورسم نظرية سياسية على ضوء ذلك. ويستدرك متسائلا: "لكن الإشكالية التي تواجهنا هي أي معيار معين نعتمده في تحديد مفهوم اليسار؟ فهل نعتمد الماركسية أساسًا لتمييز اليساري من غيره؟ هل نعتمد الانتماء الطبقي معيارًا لذلك؟ هل نعتمد المطالب المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والطفولة والنسوية .. لتمييز اليساري من غيره .. وهل نعتمد الموقف العام من الإمبريالية أساسًا لذلك التمييز، هل الأساس في هذا التمييز فكري أو سياسي أو طبقي اجتماعي؟
للتمييز بين مفهوم اليسار وغيره من المفاهيم على صعيد العالم يعتمد التيار الذي بإمكانه استهداف الرأسمالية وتجاوزها عبر الاشتراكية التي من خلالها يتم تشريك الاقتصاد، وترسيخ النظام الديمقراطي للمجتمع، وتحقيق المساواة وفسح المجال أمام الرقابة والادارة الاجتماعية العامة ثم ليكون لها الدور الرئيس في قيادة المجتمع.
الباحث يقدم صورة مختزلة تأريخية عامة لليسار، ويصنف مراحل ظهوره على وفق التصنيف الآتي: "مرحلة اليسار القديم، مرحلة اليسار الجديد وموقفها من العنف، مرحلة اليسار المعاصر".
وفيما يخص مرحلة اليسار المعاصر يذهب الباحث إالى اعتبار "الليبرالية الجديدة" إنما هي النظام الاقتصادي الذي يحكم العالم منذ نحو خمسين عامًا، ملحقة الضرر بملايين البشر، وانّ هذا المذهب الاقتصادي يسوّغ: "إطلاق حرية الأفراد وتقليص دور الحكومات في الاقتصاد لأكبر درجة ممكنة، ويشجع على إزالة الضوابط على حركة رأس المال الخاص، وبالتالي الخصخصة، ومعاداة التنظيمات النقابية وغيرها، وباختصار هو أحد أشكال الاقتصاد الحر، لكن خصومه يرونه أكثر تطرفًا وإضرارًا بالفقراء والعمال".
ولعبت الليبرالية الجديدة دورًا رئيسيًا، بتأكيد الكاتب والباحث فرحان قاسم، في مجموعة من الازمات التي واجهت العالم والمجتمعات البشرية، ولعل من أبرزها: "الانهيار المالي الذي حدث في عام 2007، وانتشار مراكز "الافشور" المالية التي يخفي فيها الاثرياء اموالهم، بعيدًا عن سلطات الضرائب، والانهيار البطيء في قطاعات الصحة والتعليم، زيادة الفقر، انتشار الأمراض النفسية، انهيار النظم البيئية".
وتناقش صفحات الخاتمة عددًا من القضايا والأفكار والأحداث العالمية التي لعبت دورًا بارزًا في ظهور نظرية ممارسة اليسار، وصراعها التأريخي مع النظام الرأسمالي وكل التيارات التي خرجت من معطفه بعد الحرب الكونية الثانية. ولعل من أبرزها: "ارتباط مستقبل الرأسمالية بمستوى تخلف وتبعية البلدان الطرفية للمركز، انحسار المد الثوري في اوروبا بعد انطفاء نيران الحرب العالمية الأولى، ربط الماركسية بين تطور الرأسمالية وازدياد غناها بتخلف البلدان الطرفية وتزايد فقرها، مهمة رفع مستوى الوعي والادراك الجماهيريين في الكشف عن مشروع الرأسمالية ومخرجات نتائجه التدميرية، مهمة اختراق مؤسسات الدولة التدريجي، ظهور فكرة عولمة التضامن كرد مباشر على فكرة عولمة رأس المال، ضرورة خلق نظرية سياسية متبناة من حركات الاشتراكية كافة في العالم".
وينختم الكتاب بالدلالة والاستنتاج والرؤية في إزاحة وتجاوز الرأسمالية، المتن الذي كشف عن رؤى عميقة واستنتاجات استقرائية ذات نهج موضوعي وحيادي في مناقشة افكار وقضايا واحداث متن الكتاب بكل تفاصيل فصوله السبعة، فضلا عن ذلك يحيلنا الباحث الى الصراع التأريخي المعاصر بين حركات اليسار، والنظام الرأسمالي المتسيّد على العالم استغلالًا، واستحواذًا، وغزوًا، وهيمنة، وحروبًا، وصناعة الاستبداد والموتٍ العدوانيّ لشعوب دول الأطراف. إنّ: "الإمبريالية وعولمتها الرأسمالية دفعت بقوى اجتماعية جديدة لتكون في صف المناوئين للعولمة الرأسمالية، ونتيجة هذا التحول النوعي في الاصطفافات والتحالفات الطبقية فإن مهمة تجاوز الرأسمالية لم تعد مقصورة الحركات والأحزاب والطبقات المضادة للعولمة ضمن نطاق البلدان الرأسمالية المتقدمة فقط، وإنما على اتساع لتعم العالم كله".
-
الكتاب صدر عن دار جلجامش / بغداد 2025