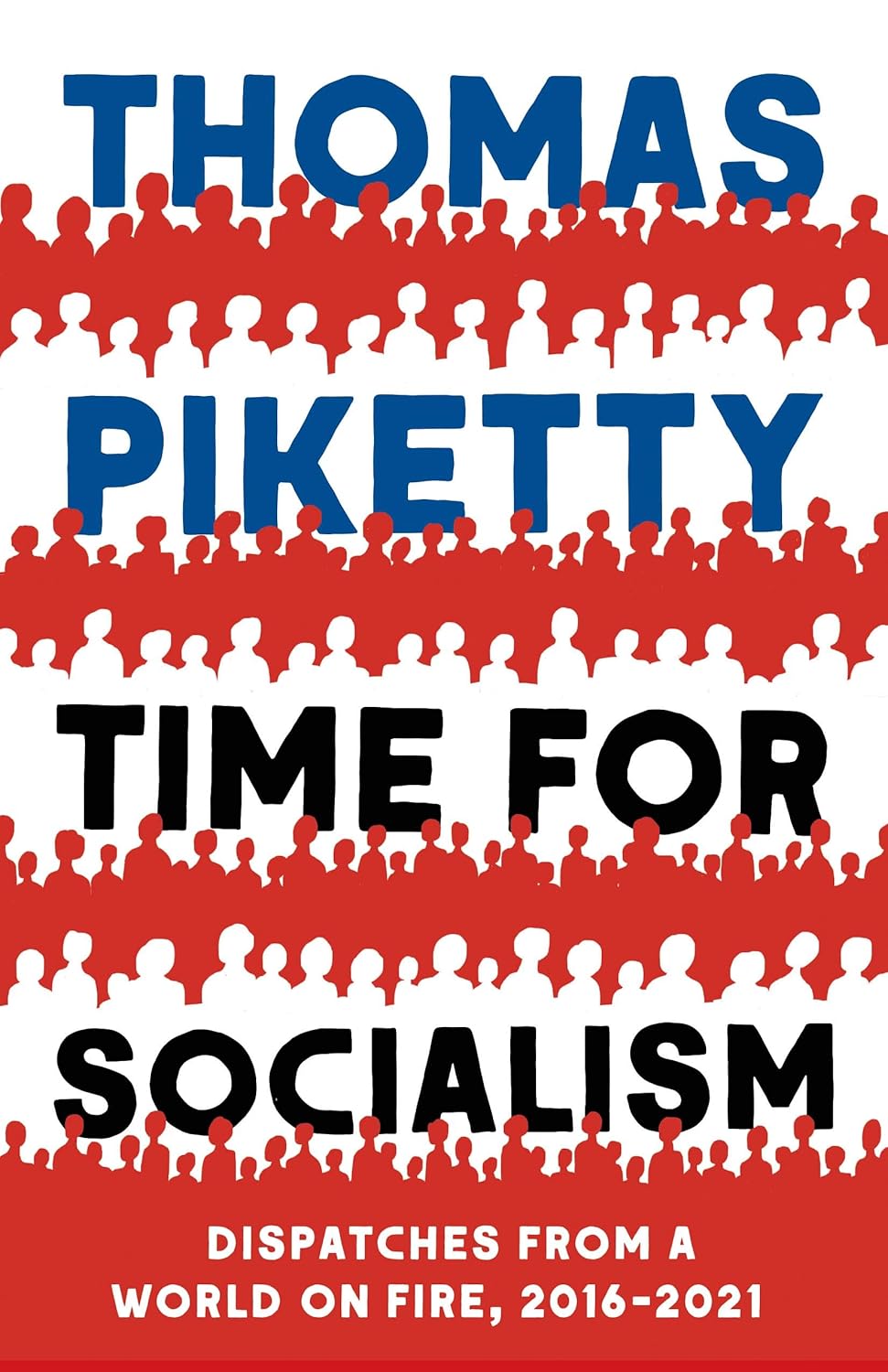
يبدأ الكاتب بالفقرة التالية: " بعد ثلاثين عامًا، في عام 2020، كانت الرأسمالية المفرطة قد تجاوزت حدودها بكثير، وكنت قد أصبحت مقتنعًا تمامًا بضرورة التفكير في سبيل جديد لتجاوز الرأسمالية، في شكل جديد من الاشتراكية: اشتراكية تشاركية ولا مركزية، فدرالية وديمقراطية، بيئية، متعددة الأعراق، ونسوية "(ص9).
لنبدأ بتصريح قد يبدو مفاجئًا للبعض: إذا نظرنا إلى الأمور من منظور بعيد المدى، فإن المسيرة الطويلة نحو المساواة والاشتراكية التشاركية قد بدأت بالفعل وتسير قُدما. لا يوجد أي عائق تقني يمنعنا من مواصلة هذا الطريق المفتوح، شريطة أن ننخرط فيه جميعًا. فالتاريخ يُظهر أن اللامساواة ليست مسألة اقتصادية أو تكنولوجية بقدر ما هي مسألة أيديولوجية وسياسية (ص 10).
المأساة هي أن برنامج ترامب سيعزز فقط الاتجاه نحو مزيد من التفاوت. فهو ينوي إلغاء التأمين الصحي الذي تم منحه بصعوبة للعمال ذوي الأجور المنخفضة تحت إدارة أوباما، ويدفع بالبلاد إلى مسار الانحدار المالي، مع خفض معدل ضريبة الشركات من 35% إلى 15%، في حين أن الولايات المتحدة كانت قد قاومت هذه السباق المحموم ضد الزمن الذي جاء من أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة النزعة العرقية في السياسة الأمريكية لا تبشر بالخير للمستقبل إذا لم يتم إيجاد تسويات جديدة. هنا دولة يصوت فيها 60% من الأغلبية البيضاء لحزب واحد، بينما يصوت أكثر من 70% من الأقليات للحزب الآخر، حيث أن الأغلبية على وشك فقدان تفوقها العددي (70% من الأصوات في عام 2016، مقارنة بـ 80% في عام 2000، ومن المتوقع أن تصبح 50% في عام 2040). (ص 48)
اِلغاء ضريبة الثروة خطأ تاريخي
إليك الحقائق الرئيسية: بين عامي 1980 و2016، ارتفع الدخل الوطني المتوسط لكل بالغ، المُعبّر عنه باليورو لعام 2016، من 25,000 يورو إلى أكثر من 33,000 يورو، أي بزيادة تقدر بحوالي 30%. في نفس الوقت، تضاعف متوسط الثروة المملوكة من العقارات لكل بالغ، حيث ارتفعت من 90,000 إلى 190,000 يورو. وأكثر ما يثير الدهشة: ثروة أغنى 1%، التي تتكون بنسبة 70% منها في الأصول المالية، ارتفعت من 1.4 مليون يورو إلى 4.5 مليون يورو، أي أنها زادت ثلاث مرات. أمـا بالنسبة لـثروة 0.1% الأغنى، فان نسبة 90% مـن ثرواتهم هي في الأصول المالية، والذين سيكونون المستفيدين الرئيسيين من إلغاء ضريبة الثروة، فقد ارتفعت ثرواتهم من 4 ملايين إلى 20 مليون يورو، أي أنها زادت خمس مرات. بمعنى آخر، ارتفعت أكبر الثروات في الأصول المالية بشكل أسرع من الثروات العقارية، في حين كان من المفترض أن يكون العكس هو الصحيح إذا كان غرض الهروب الضريبي مبررًا (ص 122).
ما يثير القلق أكثر هو الزيادة الكبيرة في عدد الطلاب، حيث ارتفع من أكثر من 2.2 مليون في 2008 إلى ما يقرب من 2.7 مليون في 2018، أي بزيادة تقدر بحوالي 20%. عندما ندمج نمو الميزانية (الذي لم يتجاوز 10% في مصطلحات حقيقية) مع الزيادة في عدد الطلاب (20%)، فإن الاستنتاج الحتمي هو أنه بين عامي 2008 و2018، انخفضت الميزانية المخصصة لكل طالب بنسبة تقارب 10%. (ص 126).
العقوبات التجارية الأمريكية، على الرغم من غبائها الظاهري، هي مجرد إشارات رمزية تسمح لترامب بالتمييز عن الديمقراطيين وركوب الموجة القومية بتكلفة منخفضة (144).
دعوني أُذكّر بأهم فارقين: الدخل القومي يساوي الناتج المحلي الإجمالي ناقص الدخول التي تذهب إلى خارج البلاد (أو مضافًا إليه الدخول القادمة من الخارج، بحسب وضع كل بلد)، ومطروحاً منه استهلاك رأس المال، الذي ينبغي من حيث المبدأ أن يشمل استهلاك رأس المال الطبيعي بجميع أشكاله.
للتوضيح، لنأخذ مثالًا بسيطًا: إذا جرى استخراج 100 مليار يورو من المحروقات من باطن الأرض (أو من الأسماك من البحار)، فإن الناتج المحلي الإجمالي يزيد بمقدار 100 مليار يورو إضافية. لكن بما أن مخزون المحروقات (أو الأسماك) قد انخفض بالمقدار ذاته، فإن الدخل القومي لم يزدد ولو بفلسٍ واحد. وإذا أضيف إلى ذلك أن حرق المحروقات يساهم في جعل الهواء خانقًا والكوكب غير صالح للحياة، فإن الدخل القومي الناتج عن هذا النشاط سيكون سلبيًا في الواقع، شريطة احتساب الكلفة الاجتماعية لانبعاثات الكربون بشكل صحيح.
استخدام الدخل القومي والثروة الوطنية بدلًا من الناتج المحلي الإجمالي، والتركيز على التوزيع بدلًا من المتوسطات، لا يكفي بالطبع لحل كل المشكلات - بعيدًا عن ذلك. فمن الضروري أيضًا مضاعفة المؤشرات المتعلقة بالمناخ والبيئة (مثل حجم الانبعاثات، ونوعية الهواء، وتنوّع الأنواع الحية). لكن من الخطأ أن نتخيل أننا قادرون على خوض النقاشات القادمة بهذه المؤشرات وحدها، دون الرجوع إلى مفاهيم الدخل أو الثروة. فلكي نُرسّخ معايير جديدة للعدالة تكون مقبولة على أوسع نطاق، من الضروري أن نكون قادرين على قياس الجهود المطلوبة من مختلف الفئات الاجتماعية. وهذا يستلزم القدرة على المقارنة بين مستويات الثروة داخل كل بلد، وأيضًا بين البلدان، وعلى مدى الزمن. (ص 220).
لقد غادرت المملكة المتحدة رسميًا الاتحاد الأوروبي قبل أيام قليلة فقط. لذلك، فلنكن واضحين: إلى جانب انتخاب ترامب في الولايات المتحدة عام 2016، يُعدّ هذا تحولًا كبيرًا في تاريخ العولمة. فالبلدان اللذان كانا قد اختارا الليبرالية المتطرفة في عهد ريغان وتاتشر في ثمانينيات القرن العشرين، وشهدا منذ ذلك الحين أعلى مستويات تزايد اللامساواة، قررا بعد ثلاثة عقود أن يعودا إلى القومية وحدود الهوية الوطنية.
يمكن النظر إلى هذا التغير في الاتجاه من زوايا مختلفة. فهو يُعبّر، بطريقة ما، عن فشل الريغانية والتاتشرية. فالطبقات الوسطى والعاملة في بريطانيا وأمريكا لم تنل الوفرة الموعودة التي بشّرت بها الليبرالية المطلقة، وسياسات "دعه يعمل"، وإلغاء القيود الاقتصادية. ومع مرور الوقت، وجد هؤلاء أنفسهم تحت ضغط متزايد بفعل المنافسة الدولية والنظام الاقتصادي العالمي. وكان لا بدّ من إيجاد مذنبين.
فبالنسبة لترامب، كان المذنبون هم العمال المكسيكيون والصينيون وكل أولئك الماكرين حول العالم الذين يُقال إنهم سرقوا ثمرة كدح أمريكا البيضاء. أما بالنسبة لأنصار بريكست، فقد كانوا العمال البولنديين، والاتحاد الأوروبي، وكل من يُهدد عظمة بريطانيا. لكن الانكفاء على القومية والسياسات القائمة على الهوية لن يحل أبدًا التحديات الكبرى لعصرنا، المرتبطة بعدم المساواة والاحتباس الحراري.
بل إن أنصار ترامب والبريكست قد أضافوا طبقة جديدة من السياسات الضريبية والاجتماعية التي تخدم الأثرياء والأكثر تنقلاً، مما سيزيد من اللامساواة والإحباطات (ص 222).
ويبدو أن قسمًا متزايدًا من الصحافة يعتقد أن "اليسار" هو المسؤول عن صعود الإسلاموية عالميًا بسبب تساهله، ودعمه للعالم الثالث، وسعيه إلى الكسب الانتخابي. لكن الواقع أن الناخبين من أصول شمال أفريقية أو أفريقية جنوب الصحراء يصوّتون لليسار أساسًا بسبب العداء العنيف الذي تُبديه تجاههم الأحزاب اليمينية والمتطرفة. وينطبق الأمر ذاته على الناخبين السود في الولايات المتحدة أو المسلمين في الهند (ص 223).
فوق كل الخصوصيات الوطنية، يجب أن يُنظر إلى البريكست أولاً وقبل كل شيء باعتباره نتيجة لفشل جماعي في الطريقة التي نُظّمت بها العولمة الاقتصادية منذ ثمانينيات القرن العشرين، خصوصًا داخل الاتحاد الأوروبي.
فالقادة الأوروبيون، وخاصة الفرنسيين والألمان، يتحملون مسؤوليتهم في هذا. فحرية حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات، من دون أي تنظيم جماعي أو سياسات ضريبية واجتماعية مشتركة، كانت تصب في صالح الأغنى والأكثر قدرة على التنقل، وتضرّ بالفئات الأكثر حرمانًا وهشاشة.
ولا يمكن تحديد مشروع سياسي أو نموذج تنموي بالاعتماد على التجارة الحرة والمنافسة بين الجميع وانضباط السوق فقط. هذا الفخ، الذي يعني انهيار الاتحاد الأوروبي، لا يمكن تفاديه إلا بإعادة تعريف جذري لقواعد العولمة من خلال مقاربة "فدرالية اجتماعية". أي، لا بد أن تكون التجارة الحرة مشروطة بتحقيق أهداف اجتماعية ملزمة، تُجبر الفاعلين الاقتصاديين الأكثر ثراء وتنقلاً على المساهمة في نموذج للتنمية المستدامة والعادلة (ص 224).
تعزز الدولتان تعاونهما في السياسات الأوروبية... وتعملان على بناء اتحاد أوروبي تنافسي قائم على قاعدة صناعية قوية، تشكّل أساسًا للازدهار، وتعزز التقارب الاقتصادي والضريبي والاجتماعي، وكذلك الاستدامة بجميع أبعادها (ص 226).
وفي المقابل، لم تحصل مقترحات إنشاء مجموعات عمل حول التقارب الاجتماعي والضريبي بين فرنسا وألمانيا، والتي دعمها على وجه الخصوص فابيو دي ماسي (من حزب دي لينكه) ودانييل أوبونو (من فرنسا الأبية)، على الأغلبية. يبدو التركيز على هذا المشروع اشبه باستمرار النهج المألوف للسوق الواحدة، على النمط الذي ساد في تسعينيات القرن العشرين، والذي استفاد منه في الأساس الرابحون الكبار آنذاك.
من خلال هذا التوافق بين فرنسا والمانيا بشأن ضرائب الشركات، ستتمكن أوربا من كسر الحلقة المفرغة من التنافس الضريبي والاجتماعي بين الدول، التي تقوض الاتحاد الأوروبي منذ منتصف التسعينيات. وسيسهم ذلك في تحقيق "تقارب اجتماعي واقتصادي تصاعدي داخل الاتحاد الأوروبي"، كما نصت على ذلك ديباجة معاهدة آخن. وهذا أحد المفاتيح الجوهرية لمكافحة التفاوتات الضريبية والاجتماعية التي تهدد تماسك مجتمعاتنا الأوروبية، من خلال تصادمها مع البُنى الأخلاقية العميقة فيها، وتسهم في تغذية الاحتجاجات الشعبوية والاستبدادية (228).
كما أن ساندرز يقترح رفعًا كبيرًا في الحد الأدنى للأجور (وهو مجالٌ كانت الولايات المتحدة رائدةً فيه لزمن طويل)، ويقترح أيضًا الاستفادة من التجارب الناجحة في ألمانيا والسويد في مجالي الإدارة المشتركة وحقوق التصويت للموظفين في مجالس إدارة الشركات (231).
وإذا ما نظرنا بدقة أكبر، نجد أن هناك تفاوتًا بنيويًا في المشاركة بين نصف الناخبين الأفقر ونصفهم الأغنى، يصل إلى 15-20%، وهو تفاوت بدأت أوروبا تشهدُه بدورها منذ تسعينيات القرن الماضي، وإن كان بدرجة أقل وضوحًا. ولتفادي الكارثة، ما نحتاجه هو دولة اجتماعية، لا دولة سجون. الرد المناسب على الأزمة يجب أن يكون إحياء الدولة الاجتماعية في الشمال، والأهم من ذلك تسريع بنائها في الجنوب.
فهذه الثروات تستند إلى نظام اقتصادي عالمي (من الاستغلال الوحشي للموارد البشرية والطبيعية للكوكب وعلى مر القرون)، ولذلك فهي تتطلب تنظيمًا على المستوى العالمي لضمان استدامتها الاجتماعية والبيئية، بما في ذلك من خلال تطبيق "بطاقة كربون" تسمح بمنع الانبعاثات الأعلى.
التحولات الأيديولوجية والسياسية الكبرى لم تبدأ بعد إلا بالكاد. في المقام الأول، يجب أن نغتنم هذا التوقف القسري لإعادة الانطلاق على أسس مختلفة. فبعد ركود من هذا النوع، سيتعيّن على السلطات العامة أن تلعب دورًا محوريًا في استعادة النمو والتوظيف. ولكن لا بد من القيام بذلك عبر الاستثمار في قطاعات جديدة (الصحة، الابتكار، البيئة)، وبتبني قرار واضح بتقليص الأنشطة الأكثر توليدًا للكربون تدريجيًا وعلى نحو دائم.
عمليًا، لا بد من خلق ملايين الوظائف وزيادة الأجور في المستشفيات والمدارس والجامعات، وفي إعادة تأهيل المباني حراريًا، والخدمات المجتمعية لكن طبع النقود، الذي تم اتخاذ قراراته خلف أبواب مغلقة، ومن دون أساس ديمقراطي كافٍ، قد ساهم أيضًا في ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات، وفي زيادة ثروات الأثرياء، من دون أن يحل المشاكل الهيكلية للاقتصاد الحقيقي (نقص الاستثمار، تزايد عدم المساواة، وأزمة البيئة) (ص 238).
في المملكة المتحدة، كما في فرنسا، كان إلغاء العبودية مصحوبًا في كل مرة بتعويضات لمالكي العبيد تم دفعها من أموال دافعي الضرائب. بالنسبة للمثقفين "الليبراليين" مثل توكفيل أو شويلشر، كان هذا أمرًا بديهيًا: إذا تم حرمان هؤلاء الملاك من ممتلكاتهم (التي كانت قد تم الحصول عليها قانونيًا بعد كل شيء) دون تعويض عادل، أين ستنتهي هذه الحالة الخطيرة؟
أما بالنسبة للعبيد السابقين، فقد كانت تجربتهم في الحرية تنطوي على عمل شاق للغاية. وكان تعويضهم الوحيد هو التزامهم بالحصول على عقد عمل طويل الأمد مع مالك الأرض، دون ذلك كانوا يُعتقلون بتهمة التشرد. وتم تطبيق أشكال أخرى من العمل القسري في المستعمرات الفرنسية حتى عام 1950. ترفض فرنسا أي مناقشة حول موضوع الدّين الذي فرضته فرنسا على الهايتيين (كعقوبة) بسبب رغبتهم في وضع حد لعبوديتهم. المدفوعات التي تمت من عام 1825 إلى 1950 موثقة بشكل جيد ولا يطعن فيها أحد. اليوم، لا يزال يتم دفع تعويضات عن الاستيلاء الذي حدث خلال الحربين العالميتين. من المحتمل أن يتسبب ذلك في شعور هائل بالظلم ولكن تمامًا كما هو الحال مع إعادة توزيع الممتلكات، لا خيار أمامنا سوى الوثوق بالنقاش الديمقراطي لمحاولة وضع قواعد ومعايير عادلة. أي رفض للنقاش يعني الاستمرار في الظلم. علاوة على هذا النقاش الصعب ولكنه ضروري بشأن التعويضات، يجب علينا أيضًا، وفي المقام الأول، أن نوجه أنظارنا إلى المستقبل. لإصلاح الأضرار التي ألحقتها العنصرية والاستعمار بالمجتمع، يجب أن نغير النظام الاقتصادي ونؤسس أساسًا لتقليص التفاوتات وضمان الوصول المتساوي لجميع النساء والرجال إلى التعليم والعمل وامتلاك الممتلكات (بما في ذلك الإرث الأدنى)، بغض النظر عن الأصل، سواء للأشخاص السود أو البيض. يمكن أن تسهم الحركات الحالية، التي تجمع المواطنين من جميع الخلفيات، في تحقيق هذا الهدف (244).
هل يمكننا استعادة المعنى الإيجابي لفكرة الأممية؟ نعم، ولكن بشرط أن نتخلى عن أيديولوجية التجارة الحرة غير المقيدة التي قادت العولمة حتى الآن ونعتمد نموذجًا جديدًا للتنمية يعتمد على مبادئ واضحة من العدالة الاقتصادية والمناخية. الأممية في أهدافها النهائية سيادية، وفي صيغتها العملية عدالة اقتصادية ومناخية.
الادعاء بأن هذا النوع من الطريق سهل ويتبع إشارات واضحة سيكون أمرًا سخيفًا: لا يزال يجب اختراعه بالكامل. لكن الخبرة التاريخية تظهر أن القومية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات غير المتساوية والمناخية وأنه لا مستقبل للتجارة الحرة غير المقيدة. سبب آخر للتفكير، ابتداءً من اليوم، في شروط الدولية الجديدة. لقد تم إلغاء الديون العامة الكبيرة في فترة ما بعد الحرب من خلال فرض ضرائب استثنائية على الأغنياء، وتم إعادة بناء الاتفاق الاجتماعي والإنتاجي في العقود التالية. لنتراهن أن نفس الشيء سيحدث في المستقبل (ص249).
بفضل الجهود المشتركة لـ 150 باحثًا من جميع القارات، قامت قاعدة بيانات عـدم المساواة العالمية بوضع بيانات جديدة على الإنترنت حول توزيع الدخل في البلدان المختلفة حول العالم. ماذا تخبرنا هذه البيانات عن حالة عدم المساواة العالمية؟ على المستوى العالمي، زادت حصة أفقر 50% من سكان العالم من إجمالي دخل العالم من 7% في عام 1980 إلى حوالي 9% في عام 2020، بفضل نمو البلدان الناشئة. ومع ذلك، يجب وضع هذا التقدم في سياق أوسع، حيث ظلت حصة أغنى 10% من العالم مستقرة عند حوالي 53%، وزادت حصة أغنى 1% من 17% إلى 20% من إجمالي الدخل العالمي. الخاسرون هم الطبقات الوسطى والعاملة في الشمال، وهو ما يغذي رفض العولمة (262).
في هذه الأثناء، أصبحت الولايات المتحدة القوة العسكرية الرائدة في العالم وتمكنت من إنهاء دورة التدمير الذاتي القومي والإبادة الجماعية التي شهدتها القوى الاستعمارية الأوروبية ضد بعضها البعض بين عامي 1914 و1945. أصبح الديمقراطيون، الذين كانوا حزب الجنوب المؤيد للعبودية سابقاً، حزب الصفقة الجديدة. مدفوعين بالتحدي الشيوعي وتحرك الأمريكيين من أصول أفريقية، الذين تنازلوا عن الحقوق المدنية دون تعويضات (ص 265).
يتم وصف ناخبي الحزب الجمهوري بأنهم "لا يمكن إصلاحهم" إذا أراد الديمقراطيون استعادة أصوات الفئات الاجتماعية المحرومة، بغض النظر عن أصلها، فإنهم يحتاجون إلى بذل المزيد في مجال العدالة الاجتماعية وإعادة التوزيع. سيكون الطريق أمامهم طويلاً وصعباً. ولذلك، من الأفضل البدء الآن (ص265).
بمعنى أنه يجب أن يكون لكل دولة، وكل مجتمع سياسي، القدرة على تحديد شروط التعامل التجاري مع بقية العالم دون انتظار الاتفاق الجماعي من شركائها. المهمة لن تكون بسيطة، ولن يكون من السهل دائمًا التمييز بين هذه السيادة ذات الطابع الكوني وسيادة النمط الوطني. لذلك، من المُلح بشكل خاص الإشارة إلى الفروقات.
في فرنسا، كما في ألمانيا ومعظم الدول الأخرى، يوجد انقسام كبير في اليسار بشأن المسألة الأوروبية، وبشكل عام حول الاستراتيجية التي يجب اعتمادها في مواجهة العولمة وتنظيم الرأسمالية عبر الحدود. بينما تقترب المواعيد الوطنية بسرعة (2021 في ألمانيا، 2022 في فرنسا)، هناك العديد من الأصوات التي تدعو هذه القوى السياسية إلى التوحد. ولكن في ألمانيا، من المحتمل أن تجد الأحزاب الثلاثة الرئيسية (الحزب اليساري، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والخضر) صعوبة في التوصل إلى اتفاق، لا سيما بشأن أوروبا، ويتوقع البعض بالفعل أن ينتهي الخضر في النهاية إلى الحكم مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
أما في فرنسا، فقد بدأت القوى المختلفة في التحدث مع بعضها البعض مجددًا، ولكن لا يوجد ضمان حاليًا أنها ستتمكن من التوحد، خاصة بشأن السياسة الأوروبية. تكمن المشكلة في أن كل طرف مقتنع بأنه هو وحده على صواب. في فرنسا، يحب حزب "فرنسا الأبية" أن يذكر الجميع بأن الحزب الاشتراكي وحلفاءه البيئيين كانوا قد وعدوا قبل انتخابات 2012 بإعادة التفاوض بشأن القواعد الأوروبية. ومع ذلك، بمجرد انتخابهم، هرعت الأغلبية في ذلك الوقت إلى التصديق على معاهدة الميزانية الجديدة، دون تعديل أي شيء، بسبب عدم وجود خطة دقيقة لما كانوا يريدون فعلاً تحقيقه.
كما يصر "التمرديون" على أن الاشتراكيين لم يحددوا بعد كيف تغيرت استراتيجيتهم وأهدافهم، وكيف يمكن أن تؤدي إلى نتيجة مختلفة في المرة القادمة. يجب الاعتراف بأن انتقادهم مبرر. في الواقع، يُظهر فشل ريغان أن التركيز المفرط للملكية والسلطة لا يتماشى مع متطلبات اقتصاد دائري وحديث. فليس لأن شخصًا ما كوّن ثروة في سن الثلاثين يجب عليه أن يواصل احتكار السلطة كمساهم حتى يبلغ الخمسين أو السبعين أو التسعين من العمر.
كما أن تراجع النمو يُفسَّر أيضًا بالركود المقلق في الاستثمار التعليمي منذ تسعينيات القرن الماضي، وباللامساواة الهائلة في فرص الوصول إلى التعليم والتدريب، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا. إن التحدي المناخي والوعي الدولي المتنامي بتفاقم اللامساواة يوفران حوافز للتغيير، لكننا لا نزال بعيدين عن الهدف.
بخصوص ضرائب أرباح الشركات متعددة الجنسيات، في مشاريع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) لا تمس سوى جزء صغير منها، كما أن حجم المساهمة المقترحة يصبّ أكثر في مصلحة الدول الغنية منه في مصلحة الفقيرة. إن كتاب انتصار الظلم (The Triumph of Injustice) الذي نُشر في الولايات المتحدة من قِبل إيمانويل سايز وغابرييل زوكمان، يُظهر وجود حلول أكثر طموحًا، ويتمثل عنصرها الأساسي في الشفافية المالية والعودة إلى الضريبة التصاعدية، لتمويل الصحة والتعليم للجميع، والانتقال البيئي.
إن النجاح الذي تلقاه هذه الأفكار لدى الديمقراطيين الأمريكيين (لا سيما وورن وساندرز) يدعو إلى التفاؤل. لكن لا يمكن لأوروبا أن تظل مكتوفة الأيدي تنتظر التغيير من الولايات المتحدة. فإذا أردنا أن نتجاوز مجرد إبداء المواقف وأن نمنح الصفقة الخضراء الجديدة (Green New Deal) مضمونًا فعليًا، فإنه من الملحّ اِذاً اتخاذ تدابير قوية للعدالة الاجتماعية والضريبية في أوروبا. وربما يكون هذا أيضًا الثمن اللازم لدفع حزب العمال البريطاني للعودة إلى المدار الأوروبي وتجنّب نصر كارثي للمحافظين في الانتخابات المقبلة. بعد ثلاثين عامًا على سقوط جدار برلين.
حان الوقت لاستئناف المسيرة نحو المساواة، والاقتصاد الدائري، والاشتراكية. لكن من جهـة الحزب الاشتراكي، وحزب أوربا البيئة ـ الخضر وقـوى اليسار الأخرى غير المرتبطة بحركة “فرنسا الابية"، مثل "جيلاتيون " والحزب الشيوعي الفرنسي، يُشار إلى أن خطة "فرنسا الابية" لتغيير أوربا ليست دقيقة ومقنعة بالقدر الذي يزعمونـه. وأن جان ـ لوك ميلنشون يبـدو أحياناً أكثر اهتماماً بانتقاد (أو حتى مغادرة) الاتحاد الأوربي الحالي. بدلاً من أعادة بنائه علـى أسس اجتماعية ـ فيدرالية وأمميـة. وللأسف، فاِن هذا النقـد ليس باطلاً تماماً.
في الختام، يطرح بيكيتي تصورًا متكاملًا لاشتراكية القرن الحادي والعشرين، اشتراكية ديمقراطية، خضراء، أممية، قائمة على الشفافية والعدالة، وعلى تدخل الدولة كمحرك للعدالة لا كأداة لضبط الليبرالية الجديدة. ويقدم الكتاب خارطة طريق لإعادة توزيع السلطة والثروة، واستعادة التوازن بين الرأسمال والعمل، وبين النمو والاستدامة.
إن "وقت الاشتراكية" ليس مجرد تشخيص لحالة عالمية مأزومة، بل هو دعوة إلى تأسيس عهد جديد، يكون فيه التقدم مرادفًا للمساواة، ويكون فيه الأمل مشروعًا سياسيًا قابلًا للتحقق. إنه نداء موجَه إلى القوى التقدمية في كلّ مكان: لتوحيد الجهود، وتجاوز الانقسامات، وإطلاق ديناميكية جديدة نحو اقتصاد أكثر عدلاً، ومجتمعات أكثر ديمقراطية واستدامة.
عنوان الكتاب
Time for socialism: Dispatches from a world on fire, 2016-2021, Yale university press, New Haven and London, 2021.